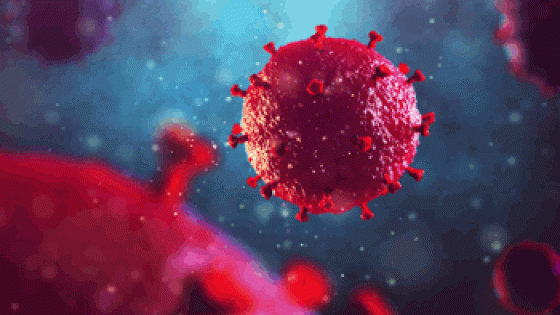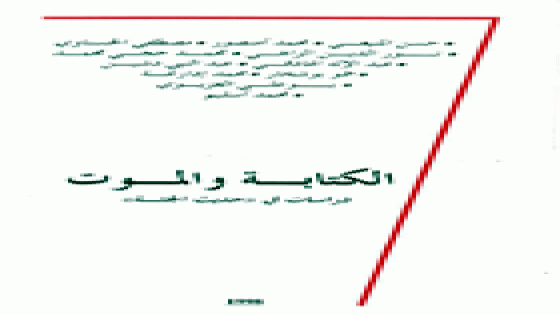يندرج المشروع الحالي الموسوم بـ «الأدب: الذاكرة والخطاب في السياق العربي الإسلامي» في انشغال يسعى لتحديد الوضع الاعتباري للكتابة، والمؤلف في المجال المذكور، مع الأخذ بعين الاعتبار للتحولات العميقة التي يلحقها حاليا التطور المذهل في حقل المعلوميات ليس بالكتاب والمؤلف والقارئ والقراءة فحسب، بل وكذلك بأشكال التواصل وحقول المعارف البشرية بكاملها، سواء على مستوى الإنتاج والنقل والإيصال أو على مستوى التلقي.
وقد تولد هذا الانشغال من ملاحظة مزدوجة: تأسيسُ الإسلام إعجازه على اللغة، إذ قدم القرآنُ نفسه باعتباره خطابا يستحيل على كافة فنون القول مجرد تقليده فأحرى مضاهاته، وهو حدث فريد في تاريخ البشرية، إذ لا نعلم بوجود شريعة دينية وضعت نفسها في ميزان الإبداع، من جهة، ومن جهة أخرى الحضور الملح لمسألة الأصل في معظم أصعدة مجال انتمائنا: الإبداع، النقد، التربية، الترجمة، بل وحتى السلوكات الاجتماعية، مما يضمر وجود خلل ما، أو مشكلة لم تحل مع هذا الأصل.
*
* *
لا يخفى أن مشروعا مثل هذا يبقى شاسعا جدا بالنظر إلى سعيه لأن يكون مساهمة مزدوجة، نظرية وعملية، كما بالنظر للأسئلة التي يثيرها عنوانه:
فهو، من زاوية سعيه لأن يكون ذا فائدة نظرية، يرمي إلى فتح زوايا جديدة للتفكير في مسألة الأصل والإيصال الثقافيين في سياقنا، بالتركيز على الحقل الأدبي.
وهو، من زاوية طموحه لأن يكون مساهمة عملية، يسعى لصياغة أسئلة من شأن الإجابة عنها المساهمة في التوظيف الجيد للرقمية في الأدب كتابة وتدريسا.
*
* *
ترتسم أمام عنوان المشروع أسئلة عديدة، منها: ما الأدب؟ ما الذاكرة؟ ما الخطاب؟ ما السياق العربي الإسلامي؟ كيف نعالج العلاقات القائمة بين الأدب والذاكرة والخطاب في المجال المعني؟ هل نعالج الأدب باعتباره ممارسة لغوية تدبر الذاكرتين الجمعية والفردية للمبدع (أي ذاكرة الأدب الثقافية بالمعنى الأنثروبولوجي للكلمة) أم نعالج الإنتاج الأدبي في صلته بالذاكرة الإبداعية الثاوية خلفه (أي بالتراكم السابق لكل إنتاج أدبي سواء باعتباره جنسا خطابيا أو تحققا فرديا داخل النوع)؟ أم نعالج الأدب باعتباره أحد مكونات الذاكرة الثقافية لمجتمع ما وبالتالي نبحث عن أشكال حضوره في سلوكات الأفراد والمجموعات الاجتماعية على نحو ما يتم البحث عن أشكال حضور الأساطير القديمة في التصرفات الحاضرة للأفراد والجماعات داخل مجتمع ما؟ ثم هل نتناول الأدب باعتباره خطابا، أي بوصفه مجموعة من الإنتاجات التي تندرج ضمن هذه المقولة (وهذه الوجهة تفضي إلى المقاربة النصية للإنتاجات الأدبية) أم نتطرق إليه باعتباره موضوعا للخطاب، أي بوصفه مادة تتأسس عليها لغة أخرى اصطلح على تسميتها بالنقد (وهذه الوجهة تفضي إلى مقاربة الكتبات النقدية للأعمال الأدبية)؟ إذا كان السياق العربي الإسلامي يحيل على مجال جغرافي ثقافي اجتماعي محدد، يمتد من الخليج إلى المحيط، ويتألف من 20 دولة، فهل بالإمكان، في ظل الشروط الحالية لتخزين المعلومات وتداولها الإحاطة بالظاهرة الأدبية في كل هذا السياق؟ هل يمكن التغاضي عن البعد الزمني، وهو ما يستلزم الإلمام بالتواريخ المحلية لآداب كل هذه البيئات؟ أخيرا، هل يمكن تحاشي السياق الأعم لهذا الموضوع، وهو تعامل الإنسان عامة مع ميراثه، الأمر الذي يقتضي إجراء مقارنات مع مجالات أخرى، كاليهودية والمسيحية والغرب العلماني الحداثي وما بعد الحداثي، بل وحتى الوثنيات الإفريقية وغيرها؟
سيكون من باب الادعاء الزعمُ بأن مجموع هذه الأسئلة شكلت فعلا الخلفية التي انطلقت منها المقالات المقدمة بين أيديكم، فهي وليدة تأمل لاحق لها. وإذا كنت أطرحها الآن، فذلك، من جهة، لإظهار أن عنوان المشروع يعاني من خلل ونقص جوهريين يتمثلان في ضرورة تقييده بعنوان أو عنوانين فرعيين، على نحو ما تؤكد ذلك أبجديات منهجية البحث في العلوم الإنسانية، ومن جهة أخرى لتبيين إمكانية مقاربة الموضوع من منظورين مختلفين:
– الأول أدبي، يضعه في نظرية الأدب والنقد، ويتطلب التقيد بالنقد الأدبي بمعناه الدقيق.
والثاني ثقافي يضعه ضمن محاولة لفهم الثقافة والمجتمع، ويقتضي توظيف عناصر من حقول معرفية مجاورة كالتحليل النفسي والأنثروبولوجيا.
من المنظور الثاني تم تحرير مقالات المشروع الحالي، ويمكن تبرير هذا الاختيار بسببين:
– الأول: أنه يتيح التعاملَ مع كل ما يلج حقل التداول بصفته أدبا واستثمارَ كل ما يتخذ الأدب موضوعا للتحليل والنقد والانتقاد وإصدار الأحكام، وذلك بصرف النظر عن الحدود المرسومة بين الخطابات.
– الثاني: كونه يجنب الوقوع في التطبيق الآلي لنظريات نقدية غربية على نصوص أو موضوعات أدبية عربية، على نحو ما تفعل العديد من الكتابات النقدية المغربية والعربية، التي تبدي النقد الأدبي بمثابة فرع محلي للمؤسسة النقدية الغربية أو مختبرا ملحقا بها…
*
* *
إذا كان المشروع الحالي يعالج موضوعا مطروقا بكثرة، فإنه سعى إلى توفير عناصر التميز والإغناء من خلال مواربة بسيطة تتمثل في تجنب الوقوع في أسر إطار نظري واحد للبحث، وذلك انطلاقا من قناعة تعتبر الأطر المرجعية والنظريات والمناهج إنما أوجدت في الأصل لخدمة موضوع الدراسة، لا العكس على نحو ما بين ذلك د. سعيد بنگراد في دراسة حديثة له موسومة بـ «ممكنات النص ومحدودية النموذج النظري».
تتمثل أهمية النظرية الفرويدية، من زاوية اهتمام المشروع الحالي، في جملة نقط نكتفي بذكر أهمها، وهي:
– أنه بات مؤكدا أن هذا النموذج شكل إلى جانب البنيوية والماركسية المنحدر الذي تولد منه مفهوم النص ما بعد الحداثي في نهاية الستينيات، وفي فرنسا بالخصوص، حيث «صار يتم التفكير فيه منذ تلك الحقبة باعتباره شذرة من اللغة موضوعة هي نفسها في منظور للغات، إذ لصياغة تصور جديد للنص، ارتكز المنظرون مابعد البنيويون على اعتباطية العلامة على نحو ما يعرفها سوسور وعلى النقد الماركسي والفرويدي للذات الكلاسيكية وعلاقتها باللغة». ومعلوم أن ثمة شبه إجماع بين منظري الأدب الرقمي حاليا على تأصل ما يسمونه بـ «النص التشعبي» في تنظيرات: فوكو، رولان بارث، جاك ديريدا، جوليا كريستيفا، وجيل دولوز، المتعلقة بالنص والمؤلف والقراءة.
بيد أنه مع اختيار النموذج الفرويدي، تم تفادي ما أمكن الوقوع التطبيق الآلي لكتابات فرويد حول الأدب والنقد الأدبي التحليلي النفسي الذي لا تعدم تطبيقاته في العالم العربي، لأن قصدَ المشروع توظيفُ بعض عناصر النظرية وليس اختبار هذه النظرية أو البرهنة على صحتها.
على النحو نفسه، تم التعامل مع الكتابات الأنثروبولوجية المسخرة في تحرير مقالات المشروع: إذ بدل الانغلاق داخل مدرسة محددة، تم توظيف كتابات متنوعة بعضها تحليلي والآخر نظري، وشق ثالث ينكب على تاريخ هذا الحقل المعرفي بمكوناته الفرعية.
*
* *
يمكن اعتبار الموضوع الحالي مساهمة في فهم كيفية تدبير المجتمع والثقافة العربيين لمسألة الأصل، من أجل اقتراح صيغ لهذا التعامل. إذا كان الإنسان لا يملك إطلاقا إمكانية اختيار أصله، فإنه يملك بالمقابل حرية تدبير علاقته بهذا الأصل. ولا حاجة لإثبات أن هذا التدبير يعتبر إحدى المعضلات الكبرى التي تعاني منها المجتمعات والثقافة العربيين لدرجة أن أي تغيير جوهري لم تتم ملاحظته على امتداد أزيد من قرن، أي منذ ظهور ما يصطلح على تسميته بـ «حركة النهضة»؛ سواء على الصعيد اللغوي، وضمنه الأدب، أو الصعيد الاجتماعي.
يبدو أن هذا الثبات يعود لوجود نوعين من الأصوليات: هناك الأصولية الدينية التي أمام إكراهات التحول التي تطبع حياتنا المعاصرة على كافة الأصعدة، اختارت منحى حلميا وطوباويا يتمثل في الدعوة إلى العودة إلى أصول يفترض أنها نقية وطاهرة، والحال أن العديد من الدراسات أظهرت عكس ذلك تماما، فضلا عن أنه بات مؤكدا أن هذه العودة مستحيلة. لكن هناك أيضا ما يمكن تسميته بـ «الأصولية الثقافية والمعرفية» التي ترفض بدورها كل تغيير، تتخذ من الماضي ذرعا واقيا أمام كل تحول، لأسباب ليست قدسية دائما، وليست شعورية دائما.
ونظن أن الأصولية الثقافية هي أشد خطرا على المجتمع والثقافة العربيين من الأصولية الدينية، لكونها تسيء للتراث والذاكرة من خلال تحجيره بدل جعله مصدر حياة. فهي من حيث سعيها لضمان استمرارية هذا التراث، تساهم في قتله على المدى البعيد دون تقديم أي بديل له، كما تساهم في خلق جيل منفصم نفسانيا، غير قادر على الانخراط في الإيقاع الذي يطبع محيطنا الحضاري الراهن والذي يتميز بـ: السرعة، والتحول المذهل، واللحظية والآنية (لحظية القيم، لحظية الاستهلاك)، وهيمنة قيم النسبية، ويتطلب مهارات الذكاء والقدرة على التكيف والفعالية في الإنتاج بدل التقوقع في الماضي والذاكرة.
بصرف النظر عن إيجابية هذا الإيقاع أو سلبيته، فهو يبقى واقعا مفروضا، وبالتالي فإن ضمان الاستمرارية لذاكرة ثقافية ما لا يمكن أن يتم إلا بإيجاد مكان لها في المجرى الحالي للحضارة الراهنة مثلما أي نيل لاحترام الآخر لا يمكن أن يتم إلا من خلال المساهمة الإيجابية في هذا المجرى والبرهنة على تمثله واستيعابه.
أبرز واجهات حضور الأصولية الثقافية قطاعات إحياء التراث العربي الإسلامي، والتعليم، ثم سلطات الرقابة التي تراجعت في الآونة الأخيرة أمام مد العولمة.
كان ما سبق طريقة في قول إن معادلة الحداثة والتراث، الذاكرة والحاضر، تعرف اليوم ظهور أرقام صعبة جدا، تتمثل في مد العولمة، وظهور ما يسمى بالمجتمعات المعرفية، ثم اكتساح الثورة الرقمية لكافة مجالات حياتنا وتفكيرنا، وأي سوء تقدير لأهمية هذه الأعداد من شأنه أن يفضي إلى التلاشي التام للذاكرة المحلية؛ فالمكان الجديد للميراث الثقافي اليوم هو الرقم والشبكة، وسند قراءتها الحاسوب والشاشة، ووسائل تجسيدها الخط والصوت والصورتين المتحركة والثابتة، وبيئة وجودها محكومة بقانون التنافس والصراع الذي يمضي إلى حد التصفية.
*
* *
يمكن تقسيم المساهمة المقدمة إلى ثلاث مجموعات:
المجموعة الأولى: تتألف من مقالات: الشعر والممنوع، الشعر والغواية، الكتابة والألم: وهي بمثابة خلفية للمحورين التاليين، خرجت بخلاصاتٍ أمدتنا بفرضيات للعمل كما أتاحت طرح الأسئلة التي يفترض في المحورين اللاحقين الإجابة عنها.
ففيها تم الوقوف على معطى عام يتمثل في وجود اختلاف جوهري بقدر ما هو لقاء جوهري بين النص الديني – التوحيدي على الأقل – والنص الإبداعي: فالأول يعرضُ نفسه باعتباره أصلا، انتهاء واكتمالا. ودليله على ذلك قابليته للانفتاح على عدد لا نهائي من التأويلات المختلفة، لكن في إطار ترديد معنى واحد، ومعنى ذلك أن النص الديني يختزل مهمة الإنسان إلى تفسير لكلمة الخالق. في المقابل، يمنح النص الأدبي نفسه باعتباره عملية لا تكتمل على الدوام، مفتوحة على الاحتمال، وما يلازم ذلك من عصف بالأصل نفسه. لكن، أليس الإسلام نفسه عصفا بأصل صار سينعت من الآن فصاعدا بـ «الجاهلي»؟
أتاحت العودة إلى ما يمكن تسميته بـ «اللحظة التأسيسية» لعلاقة الإسلام بالشعر، ومن خلاله بالإنتاج الإبداعي عموما، رصد جملة خطوات في التعامل مع الكتابة، يمكن إيجازها في ما يلي:
فمن خلال انتهاك القانون القديم الذي كان الشعرُ فيه يشاركُ في العنف والقتل باعتبارهما مظهرين أساسيين لمنطق اقتصادي خاص، أحل الإسلامُ نفسه قانونا جديدا، وذلك بالاشتغال في واجهتين: واجهة المجتمع وواجهة الكتابة. في المجال الأول، استبدل الإسلامُ القيم السائدة بقيم جديدة، أي محلَّ الأب القديم نصب الدين الجديدُ الرسولَ قائدا وأبا مثالا يتعيَّن على الناس من الآن فصاعدا أن يتماهوا معه؛ وبموازاة ذلك، تم حفظ النص القرآني وتدوينه، وإنزاله منزلة النص المثال الذي يستحيل على أي شعر أو نثر مضاهاته.
وهو ما أتاح الخروج بمجوعة من الأسئلة، منها: أي وضع اعتباري سيأخذه المؤلف عموما والمبدع بوجه خاص في الثقافة العربية الإسلامية؟ ما الفضاءات التي ستبتكرها الكتابة العربية الإسلامية للإفلات من رقابة الممنوع الديني؟ هل ستمتثل هذه المساحات كليا للشريعة أم ستخرق قواعدها؟
ومع أن هذا القسم لا يشكل أكثر من مدخل لمعالجة هذه الأسئلة، فإنه أتاح اقتراح جوابين عن بعض الأسئلة التي تثيرها قراءة مؤلفي الباحث المغربي عبد الفتاح كيليطو: «الكتابة والتناسخ»، و«لسان آدم»، منها: لماذا كان العرب القدماء يتهيبون أمام الكتابة؟ لماذا كان يتم أحيانا تحاشي إعلان الذات عن انتسابها لمجتمع المؤلفين، ونحلها ما تكتبه لسلطات كتابية مكرسة؟ لماذا تم نسبة أقدم قصيدة في الدنيا لآدم؟ كيف نفسر هذا التأرجح بين اعتبار آدم هو ناظم أقدم مرثية في العالم واعتبار عدنان هو الشاعر الأول؟
كما مكن القسم نفسه من الخروج بثلاث نقط:
1 – البرهنة على اندراج الشعر ضمن النظرية الكوزموغونية الإسلامية، والوقوف على وجود ما أسميناه بـ «أسطورة أصل الشعر في الإسلام» مُصاغة على النمط نفسه الذي صيغت به «أسطورة أصل السحر، حيث تم اعتبار الشعر، مثل السحر، منحدرا من أصل مزدوج: رباني وشيطاني، قدسي ودنيوي: أقدم قصيدة في الدنيا صاغها آدم و أو عدنان، وأول الوصفات السحرية نقلها للناس الملكان هاروت وماروت أو شياطين سليمان.
2 – رسم حدود المساحة التي تصورها الإسلام للإبداع، وهي عبارة عن ميدان وسط بين القدسي والدنيوي، الأمر الذي يجعل الكتابة في هذا السياق مهددة على الدوام بالوقوع في محظور ممنوع الاقتراب من قدسية النص الديني إلى حد الاختلاط به، أو ممنوع الابتعاد عن القدسية إلى حد الوقوع في ضلال الشيطان.
3 – صياغة خطاطة عامة لقراءة مجموع أغراض الشعر العربي القديم، تتألف من خمسة عناصر، هي: الشعر والكلام، مدخل الشيطان ومدخل الشعر، الشعر والسِّحر واللعب، الشعر وحدَّا الغواية، ثم الشعر والذِّكر.
أما الفئة الثانية من المقالات، فتتألف من نصوص: رمزية الجنس في رواية جنوب الروح لمحمد الأشعري، والرواية والإيصال الثقافي في رواية جنوب الروح، ودلالة التيه في ورم التيه لعبد النبي كوارة وحول مفهوم الأشكال ما قبل المسرحية، وانصبت على أربعة أعمال: اثنان منها إبداعيان هما روايتا: «جنوب الروح» لمحمد الأشعري و«ورم التيه» لعبد النبي كوارة، واثنان في النقد المسرحي، هما: «المسرح المغربي من التأسيس إلى صناعة الفرجة» لحسن المنيعي و«المسرح المغربي. دراسة في الأصول السوسيوثقافية» لحسن بحراوي. والقاسم المشترك بين مجموع هذه الأعمال، رغم تباين جنس انتمائها، هو الحضور القوي لمسألة الأصل، سواء من حيث الانتماء أو من حيث المقاربة، إذ مثلما يطرح النقد سؤال: هل الرواية والمسرح متجذران في الثقافة العربية أم أنهما مستوردان من الغرب تتخذ الروية هي الأخرى من الأصل الاجتماعي والثقافي موضوعا للكتابة.
في الرواية تم التركيز على تدبير الشخصيات لأصلها الثقافي المزدوج، من زاويتين مختلفتين، لكنهما أتاحتا الوقوف على ظاهرة «التعارض الوجداني»، بين التقليد والحداثة، ونموذجي الإيصال: الإيصال على نموذج التحجر والتكرار والإيصال المنفتح على دورتي الحياة والتجدد. أما في المسرح، فقد أفضى تحليل مفهوم «الأشكال ما قبل المسرحية» الذي تتم العودة إليه كلما أثيرت مسألة وجود تقليد مسرحي في التراث العربي الإسلامي عموما، والمغربي على الخصوص، إلى ارتكاز هذا المصطلح على خلفية أنثروبولوجية متجاوزة، من جهة، ووجود تعارض وجداني لدى الباحثين من جهة ثانية، وبالتالي اقترح تجاوز طرح «الأشكال ما قبل المسرحية» بمنظور «إثنولوجيا للمسرح المسرح المغربي».
أخيرا، تتألف المجموعة الثالثـة من مقال مقدمات للعصر الرقمي، وهو مجرد نواة لمقالات أخرى كان أولها: المشهد الثقافي العربي في الأنترنيت: قراءة أولية» الصادر مؤخرا في إحدى الأسبوعيات المغربية، وستليه دراسات أخرى حول «النص التشعبي». والمقدمات عبارة عن مدخل مصغر للثورة الرقمية التي نعيش بداياتها الآن، والتي هي بصدد تقويض العديد من الإنتاجات والسلوكات الثقافية، مما يفسح المجال للتساؤل عن الوضع الاعتباري للذاكرة الثقافية والإبداعية، في سياق هيمنة الشبكات والافتراض، والأشكال التي ستأخذها القراءة والكتابة في عالم الرقمية.
إذا صحت مقولة أنه عندما تصير كلمة ما شعبية، فذلك غالبا لكونها قادرة على إرساء تحول هام في العالم، فإنه يمكن القول إن الانتشار الواسع الذي يشهده اليوم مفهوما «النص التشعبي» و«نظرية العماء» في كافة الحقول المعرفية، يؤشر على تحول أكثر من هام سيلحق ليس بحقل الدراسات الأدبية، بل وكذلك بحقول المعارف البشرية بكاملها، سواء على مستوى الإنتاج والإيصال أو على مستوى التلقي والتداول. وننوي محورة اهتمامنا – داخل هذه التحولات – على قضايا الكتاب، والقراءة، والمؤلف، والإبداع الأدبي.
*
* *
لم تسع الصفحات السابقة إلى أكثر من إدراج المقالات المقدمة بين أيديكم في إطار عام للبحث لا نزعم إطلاقا أننا قطعنا أشواطا كبيرة فيه، كما لا ندعي امتلاك القدرة على تحقيقه فيما سيستقبل من السنين خارج توفر شروط إنجازه؛ فهو يتطلب عملا جماعيا وبنية مؤسسية للبحث، واستمرارية في الزمن…
بيد أن النزر اليسير مما تم تحريره، لا يعفي – في المقابل – من إجراء جرد لهفواته أتاح تبين ما يلي:
أ – أول ثغرة في المشروع هو الغياب التام لمقاربة الشعر الراهن، مع أن هذا الجنس الخطابي استأثر بحصة الأسد في القسم النظري المتمثل في مقالات القسم الأول التي انصبت على مسألة الإسلام والشعر.
لقد ظننت في البداية أن النص الديني لم يعد «مهددا» من قبل الشعر بقدر ما صار (مهددا؟) من قبل الأجناس النثرية، كالكتابة الصحفية، والقصة والرواية والمسرح، بالنظر للتفاوت الهائل بين جحافل الشعراء بالمقارنة مع عدد مبدعي الأجناس الأدبية الأخرى، والذي يبدو أن له صلة بظهور قصيدة النثر والتخلي عن القصيدة العمودية التي تفرض الإلمام بجملة قواعد، وفي مقدمتها العروض… ظننتُ – خطأ – أن هذا التخلي وضع حدا للعلاقة التنافسية بين النصين الشعري والديني، وأدخل الشعر في مدار يتأرجح بين قطبين: قطب الغموض والتجريد وتأسيس جماليات جديدة، لا علاقة لها – في الظاهر على الأقل – بجماليات النص الديني، وقطب الابتذال والبساطة بما جعله في متناول «يا أيها الناس».
إلا أن الراهنية كذبت هذا الظن وأعادت الشعر إلى الواجهة، ففي ظرف لا يتجاوز سنة، عاش أربعة شعراء في العالم العربي وضعية صعبة جدا: فقد تم تكفير الشاعر الفلسطيني المقيم في الأردن موسى حوامدة ومحاكمته لمرات عديدة بسبب ديوانه شجري أعلى، وتم ترحيل الشاعر الصيني المستعرب أحمد جان عثمان من سوريا بعد إقامة 20 سنة فيها، وأصدر الأزهر فتوى تكفر الشاعر المصري أحمد الشهاوي بسبب ديوانه «وصايا النساء»، وفي الأيام الأخيرة تم تكفير الشاعر اليمني عز الدين المقالح وإهدار دمه…
ب – ثاني ثغرة في نصوص المشروع عدم تمثيلية المتون الروائية المدروسة (المقدمة وغير المقدمة) لمجال البحث: فالقراءات المنجزة كلها كانت مقرونة بظروف، واقتصرت على نصوص روائية مغربية، والحال أن الأليق كان هو الرجوع إلى الكتابات التي تقوم بمسح شامل لمجموع الإنتاج الروائي العربي من أجل انتقاء عينة تمثيلية للمجال المدروس.
ج – ثالث ثغرة هي بطء الإنجاز؛ فبين سنة 1990 و2004، لم يتم تحرير سوى 8 دراسات، أربع منها هي المقدمة بين أيديكم. ولهذا البطء مبررات، أهمها:
– صرف وقت كبير في ما يمكن اختزاله في مجرد بحث وثائقي يصب في الموضوع، ويتمثل في دراسة العلاقة بين الإسلام والسحر وإنجاز ترجمات عديدة أبرزها ما يتعلق بمجالات السحر واللغة والسلطة، وما اصطلح عليه بـ «قضية الآيات الشيطانية». إلا أن هذا البحث الوثائقي نفسه يعاني لحد الساعة ثغرة عدم توظيفه بشكل معمق في الدراسات المنجزة، بحيث لا يقف القارئ في مجموع هذه الأعمال على وحدتها العميقة التي تجعل من الأدب سحرا ومن السحر أدبا.
د – يمكن الإشارة كذلك إلى عدم اعتماد نظام للإحالات موحد في سائر الدراسات المقدمة؛ فمقالة «الشعر والممنوع» تعتمد النظام الأنجلوساكسوني، فيما يعتمد الباقي النظام الكلاسيكي. والسبب في هذا التفاوت يعود إلى قرار إبقاء النصوص المقدمة على الحال الذي نشرت به.
هـ – أخيرا، تسربت مجموعة من الأخطاء المطبعية إلى نصوص المشروع، وسيتم استدراكها في نسختها الإلكترونية المنشورة في الشبكة.
*
* *
من خلال ذكر هذه الهفوات، وددت قول إنه إذ كان من فضل لي لهذه الجلسة فهو الجمع بين الأساتذة الأجلاء على بساط المناقشة في وقت يعرف فيه سهم الثقافة انخفاضا متواصلا على صعيد الأنشطة كما علي صعيد البحث النظري بفعل إكراهات التطورات الاقتصادية العالمية الراهنة؛ فقد أظهر عدد من الباحثين أن «تقوية اقتصاد السوق على الصعيد العالمي قد مارس منذ بضع سنوات ضغوطات ملحوظة ومتناقضة على البحث والجامعات الغربية»، وهو ما ينبئ بما ستصير إليه جامعتنا في بضع سنوات، إن لم تكن قد دخلت هذا المنعطف سلفا، من جهة، ويدفع، من جهة أخرى، إلى التفكير فيما إذا كانت العلوم الإنسانية، بل وربما حتى الاجتماعية، آيلة إلى أن تصير مجرد مرحلة من مراحل تطور الفكر البشري، أي ماضية إلى الانقراض على المدى البعيد بالنظر إلى التطورات المذهلة التي تشهدها حقول الجينوم والتكنولوجيتين البيولوجية والمعلومياتية.
—————
(نص المشروع المقدم لنيل شهادة الأهلية في الأدب العربي، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، مكناس، 26 فبراير 2004)
http://www.cnd.hcp.ma/
الكاتب: محمد أسليـم بتاريخ: الأحد 26-08-2012 06:16 صباحا