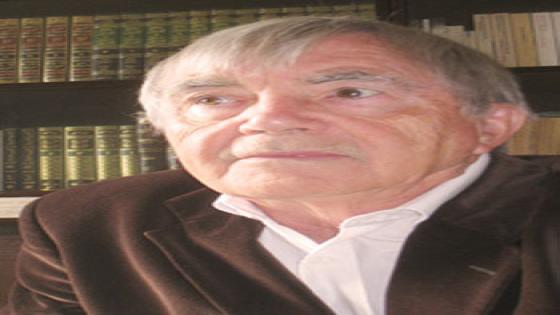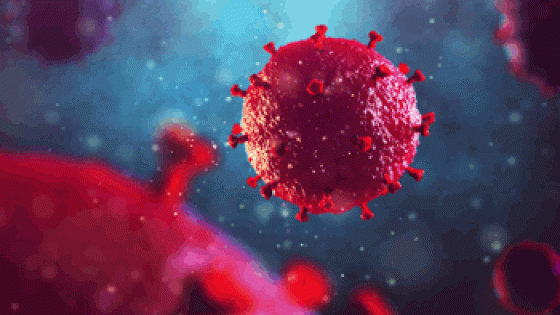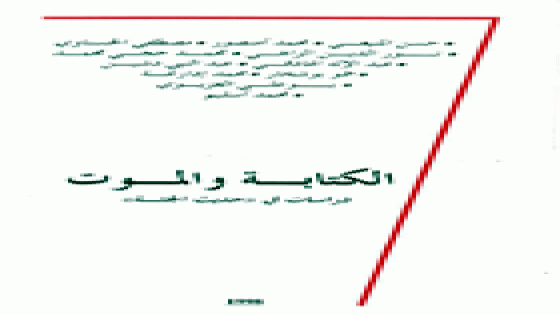أن يكون «جمال الغيطاني» اسما لا يحتاج إلى تعريف بالنظر إلى إسهاماته القيمة في الرواية العربية، فهذا ليس بالأمر غير العادي. أعمال المبدعين الكبار بطاقات تعريف لهم. لكن أن يكون الغيطاني نفسه قد تعامل مع نظام بلد آخر كشفت الإطاحة به عن أشكال للبطش والتقتيل أغرب من الخيال، فهذا ما يحتاج إلى توضيح ليس من الغيطاني وحده، بل وكذلك من سائر المثقفين العرب الذين كانوا على صلة بسفاح بغداد.
كان بإمكان المسألة ألا تطرح أصلا لو تعلق الأمر بكاتب عراقي يقيم قسرا في العراق؛ فيد الديكتاتور كانت أطول من أن يفلت – أو يتملص – منها الكتاب والفنانون والمبدعون الراغبون في الاستقلال والابتعاد عن دوائر بلاطاته وممارساتها المشبوهة. ولكن عندما يتعلق الأمر بكاتب ينتمي إلى دولة أخرى، لا أحد يجبره على الانحناء لرغبات الزعيم، فالمسألة تغدو بدون شك مثار تساؤلات عن خلفية هذا الارتباط. تساؤلات قد ترشحها إلى التحول إلى قضية ما لم يقدم المعني بالأمر التوضيحات اللازمة في شأنها. وذاك ما كان؛ إذ لا نبالغ إذا قلنا إن ما يمكن تسميته بـ «قضية الإمبراطور – جمال الغيطاني» يشكل الآن حديث الساعة في الأوساط الثقافية المصرية أولا، والعربية ثانيا، سواء في حلقات النميمة في المقاهي أو في عدد من الصحف ومجموعات المحادثة والكثير من المواقع الثقافية في الشبكة العنكبوتية.
كان بإمكان القضية نفسها ألا تؤول إلى ما آلت إليه لو لم يلجأ الغيطاني ومن سينضم إلى صفه – فيما بعد – إلى إعادة إنتاج سلوكات معظم النخب الحاكمة في الوطن العربي مع مواطنيهم: فبدل الاعتراف بما اتضح الآن أنه كان خطأ فادحا، والقيام بنوع من النقد الذاتي ومراجعة المواقف، بما يترتب عن ذلك من طلب للصفح من الشعب العراقي، على نحو ما فعل مؤخرا الشاعر الفلسطيني زياد خداش، تم السعي إلى تكميم أفواه مثيري المسألة بنعت هذه الإثارة التي تظل مشروعة، وليست سابقة في بابها، بالسلوك «البوليسي المشبوه»، «ذي النوايا السيئة» طبعا، «المحرك من لدن جهات خارجية»، والساعي إلى «الإساءة» للثقافة العربية والوحدة العربية والقومية العربية إلى آخر النعوت التي تواجه بها معظم الأنظمة العربية، على المستويات المحلية، أشد مقلقيها من المعارضين.
تقتضي الحكمة حل القضية حبيا، وذلك بأن يمتلك الشجاعة المثقفون العرب الذين كانوا يحصلون على هبات وعطايا ورواتب بعراق جبينهم، فيجتمعوا ويكفروا عن ذنبهم السابق بعقد لقاء يفضي إلى إصدار بيان أو كتاب أبيض ينورون فيه الرأي العام الثقافي العربي حول سلوكاتهم السابقة، ويعتذرون فيه للشعب العراقي. أما الإصرار على التملص من كل مسؤولية واستغلال تواري الديكتاتور لتغيير البذلة أو ملازمة الصمت المطبق أو محاولة نفي كل صلة بالنظام البائد توهما بأن الحجج قد اختفت باختفاء الجلاد، والتظاهر بمظهر البراءة والطهرانية، فذلك ملازمة لوضع الشبهة. وقد تنقلب هذه الشبهة إلى حالة للتلبس، والجريمة ستثبت بالتأكيد إذا ظهرت الحجج المكتوبة في يوم من الأيام، بالنظر إلى ما يروج اليوم من وجود أدلة للإثبات. وحتى إذا ثبت وجود هذه الحجج وتم الحيلولة دون إخراجها للرأي العام الثقافي العربي، فإن هذا الإقبار سيطرح أكثر من سؤال حول الصفقة التي ستفضي إلى هذا الإخفاء مع ما سيترتب عن ذلك تأكد شبهات أخرى…
إن السعي إلى طمس ملف علاقة مجموعة من المثقفين العرب بنظام صدام هو ضربٌ من محاولة مغالطة الرأي العام الثقافي العربي والمهتمين بشأنه، وإظهارٌ لصفوة مثقفي هذا السياق بمثابة أشخاص قدسيين لا يأتيهم الباطل من بين أيديهم ولا من خلفهم. ولعمري ذلك نوع من استبلاد القارئ العربي، بل ومعاملته معاملة القاصر الذي لا يليق مكاشفته بأمور «لا يملك النضج الكافي لفهمها واستيعابها». أليس هذا ما تفعله معظم النخب الحاكمة بالوطن العربي؟ !
– 2 –
انطلق فتيل القضية من «الإمبراطور»، وهو الموقع الرسمي، في الشبكة العنكبوتية، للشاعر الروائي العراقي المقيم في الدنمرك؛ مثقف ومبدع غير عاد بالنظر إلى حضوره الشعري والروائي المتميزين؛ أصدر 7 دواوين شعرية، ضمنها واحد نشره اتحاد كتاب العرب (صخب طيور مشاكسة، 1978)، هو موجود ضمن المنشورات الإلكترونية لموقع الاتحاد. كما كتب روايتين، إحداهما صدرت أيضا عن اتحاد كتاب العرب (التأليف بين طبقات الليل، 1997)، وموجودة في موقعه، والثانية عن الشركة العربية الأوروبية للصحافة والآداب والنشر (الحمى المسلحة، 2000). هذه الأخيرة كانت ستشكل دون شك حدثا ثقافيا عربيا فريدا ومتميزا يتمثل في ولوج أحد نصوص لغة الضاد قلعة هوليود الحصينة لولا أحداث 11 شتنبر 2001؛ ذلك أن المخرج السينمائي الدنماركي «لارس فون ترير»الذي حصد السعفة الذهبية في مهرجان كان، برسم دورة سنة 2000، عن فيلمه «راقصة في الظلام»، حولها إلى سيناريو، وبحث لها عن الموارد المالية الضرورية لإخراجها سينمائيا، فنجح، وكان التصوير سيبدأ، في إطار إنتاج مشترك أوروبي – أمريكي، ولكن سقوط برجي نيويوك أرجأ إنجاز المشروع إلى تاريخ غير محدد. فضلا عن ذلك، وهذا للتذكير لا غير، فأسعد عضو الموسوعة العالمية للشعر وعضو في اتحاد الكتاب العرب وفي اتحاد الكتاب الدنمركيين.
المقال الذي أشعل الفتيل لم يكتبه أسعد، وإنما حرره صاحبه سليم عبد القادر بعمان (الأردن) تحت عنوان «زبيبة والملك – لصدام الغيطاني»، ساردا فيه مجموعة من المعلومات المثيرة عن تفاصيل كتابة رواية «زبيبة والملك» المنسوبة إلى صدام حسين فيه، مؤكدا أنه استقاها من رعد بندر شاعر البلاط الملقب بـ «شاعر أم المعارك» الذي عاش في قصور صدام ومدحه وآله لمدة تفوق 20 سنة. فكان من الطبيعي أن يجد فيه «الإمبرطور» مادة صالحة للنشر ضمن إطار موجود سلفا هو صفحة «فضح الرموز» التي يذكر عنوانها لا محالة بكتاب نيتشه «أفول الأصنام»، هذه الصفحة لا تخص الغيطاني وحده، وإنما مجموعة من الأسماء الأخرى عربية وأجنبية (النفري، نيتشه، محمد الماغوط، مداحو صدام والقذافي)…
وسيصير هذا المقال نصا مرجعيا لكل الذين سيكتبون عن المسألة فيما بعد، سواء الذين سيقفوا ضد الغيطاني أو معه؛ فوجدت فيه صحيفة وزارة الثقافة المصرية نفسها (القاهرة) الذريعة المثلى لتصفية حساباتها السابقة مع الغيطاني، وأعادت نشر «زبيبة والملك – لصدام الغيطاني» بتصرفات بسيطة، ومضت صحيفة «صوت الأمة» أبعد، فنشرت الفضيحة تحت عنوان «امسك عميل صدام»، وسعى وائل عبد الفتاح إلى تقصي حقيقة ما ورد في النص فانقلب إلى شبه مدافع عن الغيطاني، ثم نصب عبده مازن نفسه قاضيا للبث في النازلة فانقلب إلى محام يدافع عن الروائي المتهم…
– 3 –
ثمة من لم يتردد في اعتبار أن القضية نفسها لا تشكل سوى بداية لمسلسل للكشف عن فضائح عدد كبير من الرموز الثقافية العربية، قد يحول الكتابة في هذا الباب إلى ساحة لاقتتال ميليشيات المثقفين العرب وعشائرهم… وإذا كنا لا نأمل أن يصدق هذا التوقع، لكونه لن يخدم الثقافة العربية بأي حال من الأحوال، فإنه لا يسعنا في الوقت نفسه إلا الاعتراف بأنه يصعب فهم المقاربة التي تبناها الغيطاني لمعالجة المشكل بقدر ما يشق تصور تبني هذه المقاربة من لدن صفوة من المثقفين أنصار العقلانية والحداثة والفكر الديكارتي والتمدن، إلى آخر النعوت التي يصعب على كل مثقف عربي ألا يفتخر بالاتصاف بها:
قام الغيطاني، على التوالي بـ:
أ – تكذيب أن يكون هو «كاتب زبيبة والملك»، مرجحا أن يكون كاتبها هو صدام نفسه، علما بأن المخابرات الأمريكية عكفت على النص المذكور لمدة سنة، وبعد تحليله تحليلا معمقا ومتأنيا خلصت إلى «رأي نقدي مفاده أنّ الرواية قد لا تكون من تأليف صدام حسين، الأمر الذي لا ينفي إشرافه علي إنتاجها، وحشوها بكلماته وأفكاره»، خلاصة سيصوغها تقرير حكومي (أمريكي) على النحو التالي: «إنّ أسلوب صدّام، وبنية جملته وتعابيره، ماثلة في الرواية علي نحو واضح». وقد دعم الغيطاني هذا التكذيب بالإحالة إلى تاريخ انقطاع أسفاره للعراق (1988)، وهو تاريخ سابق لظهور الرواية. وسيتولى دفاع الغيطاني مهمة التوسع في سوق الحجج المكذبة، على نحو أن الرواية «ركيكة»، وأن نعمة المكافأة المفترض أن يكون قد تلقاها الكاتب جزاء كتابته لم تظهر عليه، وأن «جمال الغيطاني كاتب وطني معروف لا يصح اتهامه بأنه كان عميلا لأي نظام حاكم»… ومن طريف ما جاء به بعض هؤلاء سعيهم إلى تنكير كل شيء، فوصف بعضهم الأيقونة – الشعار المتصدر لموقع الإمبراطور، بعين غرائبية وكأن هذا الإمبراطور كوكب مجهول تقطنه كائنات غريبة، وحاول بعضهم الآخر أن يدرج في باب النكرات ليس كاتب مقال «زبيبة والملك لصدام الغيطاني»، بل وكذلك رعد بندر شاعر «أم المعارك»، وصاحب موقع الإمبراطور نفسه !
ب – مواجهة الاتهام باتهام مضاد، حيث وصف المعلومات المنشورة بأنها: «افتراءات تمثل مرحلة جديدة في تشويه المثقفين المصريين والعرب»؛ وأنها أسلوب شرير «يعد استغلالاً سيئاً لوسيلة نشر عصرية هي الانترنت، في عملية (الـ) تشويه»؛ اتهام سيتولى دفاع الغيطاني التوسع فيه وشرحه، فيفترض أن مقال الاتهام موقع باسم مزور، وتصير المعلومات الواردة في المقال «مدبّرة تدبيراً “بوليسياً” وربما “غرائبياً”»، وتوصف بأنها «نميمة» و«تلسين» واتهام «فقط باللسان دون وجود أدلة أو مستندات»…
ج – السعي لتحديد سياق عام، وطني وقومي، تذوب فيه القضية، بحيث يصير المستهدف ليس الغيطاني وإنما فئة كاملة من الأشخاص تتمثل في «المثقفين المصريين والعرب الذين رفضوا الحرب على العراق» و«الذين يدينون الممارسات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني (أطروحة ستجد ترجمتها العملية في بيان مجلة «الآداب»)؛ لكن أيضا محاولة تصنيف ما يسميه «تشويها» ضمن ما يسمى بـ «جرائم الأنترنيت» أو «الجرائم الإلكترونية»، حيث أشار إلى وجود مواقع ترسل رسائل باسم المثقفين ومن خلالها تقوم بتشويه مسيرتهم وتتهمهم بأنواع من الشذوذ الجنسي وتزعم إصابتهم بمرضالأيدز وغير ذلك من التهم المفتراة عليهم». إلا أن مثل هذا التصنيف لا يمكن ينطوي إلا على مغالطة أو جهل بالأبجديات الأولى لثقافة «النت»؛ فمرتكب الجريمة الإلكترونية لا يكشف عن هويته أبدا، ولو كان الهدف هو الإساءة إلى الغيطاني على نحو ما أساءت الرسائل المذكورة لما قامت الحاجة إلى موقع معروف الهوية. فبالإمكان إنشاء، وفي وقت قياسي (موقع في ظرف 10 دقائق)، عشرات المواقع مجهولة الهوية، وتسجيلها في آلاف محركات البحث…
د – تبني رد فعل من جنس الذي قام به ضحايا الرسائل الإلكترونية؛ فمثلما تقدم عدد المثقفين المصريين بشكاوى إلى أجهزة الأمن والنيابة العامة ونقابة الصحافيين المصريين قبل أسابيع مطالبين بملاحقة تلك المواقع، أبلغ الغيطاني أيضا أجهزة الأمن المختصة في مصر للتصدي للافتراءات التي تستهدفه، وأكد أنه سيرفع دعوى قضاية ضد موقع الإمبراطور (تصريحات أدلى بها لعبده وائل، وصحيفتي «الشرق الأوسط» و«إيلاف» (الإلكترونية)، بغاية تحقيق أمر واحد، يتمثل في «مطالبة الإمبراطور بتكذيب ما ورد في الافتراءت المنشورة». وهو مطلب لا يتناسب والخسائر المفترض أن يلحقها المقال، بالنظر إلى قوة رد الفعل والزوبعة المثارة حوله، فرديا وجماعيا.
ج – السعي إلى «تدويل» الأزمة – إن جاز التعبير – بإصدار بيان يعبر عن استياء نخبة من المثقفين والكتاب اللبنانيين والسوريين والمصريين (والبقية آتية لا محالة)، نشرته مجلة الآداب اللبنانية، وسُلمت نسخة منه إلى وكالة «فرانس برس» بالقاهرة، يستنكر “حملة التشهير والذم والاتهامات البذيئة” ضد الغيطاني، بل ويذهب إلى حد مماهاة الثقافة العربية معه، بحيث صار «المسُّ» به «مسًّا» بها، و«الإساءة» إليه «إساءة» إليها. ورد في البيان:
«”عرف العالم العربي قبل سقوط بغداد اجتهادات فكرية لا تميّز الاحتلال من التحرير، ولا الديموقراطية من الإخضاع.وشهد بعد سقوط بغداد تنديداً بالعروبة في مختلف وجوهها، وخلطاً لازماً لا فكاك فيه بين الوحدة العربية والديكتاتورية. بل أرجع بعض المثقفين كلّ تطلّع وحدوي عربي إلى موروث متخلف بائد، مسوّغين السيطرة الأميركية على العراق وغير العراق.
في هذا السياق انطلقت حملة من التشهير والذم والاتهامات البذيئة ضد الروائي والمثقف المصري العربي جمال الغيطاني، الذي اختار أن يدافع عن الهوية العربية وأن يلتزم أخلاقية الكتابة. ولا يخفى على أحد أن أصوات النميمة والتزوير تتهم في الغيطاني التزامه ذاك، الذي يتضمن العراق وفلسطين ويتجاوزهما، وتستنكر فيه رفضه للتبشير الكاذب وتشويه الحقائق. إننا ككتّاب عرب نشجب الحملة التي يتعرض لها جمال الغيطاني، ونرفض مبدأ الاتهام الذي لا يأتلف مع القيم الثقافية بل يقمع حرية الرأي بالنميمة والتشويه، مدركين أن الدفاع عن الغيطاني دفاع ضروري عن الثقافة الوطنية العربية التي أسهم هذا الكاتب في إثرائها وتطويرها”
من لبنان وقع كل من سهيل ادريس وسماح إدريس ويمنى العيد ومحمد دكروب، ومن سوريا جمال باروت ونبيل سليمان وعبد الرزاق عيد ونهاد سريس، ومن مصر نجيب محفوظ (نوبل للآداب، 1988)، ويوسف القعيد، محمد البساطي، عزت القمحاوي، محمود أمين العالم، فريال غزول … والبقية ستأتى لا محالة بالنظر إلا أن مجلة «الآداب» وضعت رهن الراغبين عنوانا إلكترونيا لـ «لتواقيع إضافية أو لبحث هذه المسألة».
والملاحظة البارزة في هذا البيان هي هذا التعارض الوجداني بين وضع القضية في إطار عام واعتبارها مسألة شخصية تهم الغيطاني وحده: فمن جهة ثمة إقرار بوجود حملة تستهدف مناهضة العروبة والقومية والوحدة ورفض السيطرة الأمريكية، وهو ما يقتضي وقوع أسماء كثيرة تحت طائلة العملية التي المنعوتة بـ «حملة للتشهير والذم والتهامات البذيئة» و«القامعة لحرية الرأي والتعبير»، لكن، من جهة أخرى، بدل سرد بعض هذه الأسماء (انظر مقال «شعراء صدام والبعث» في الإمبراطور، مثلا) أو الإشارة إلى توقع مهاجمة أسماء أخرى، تم حصر قائمة ضحايا الحملة في شخص واحد، وهو ما يحول مسألة السياق إلى مجرد إشارة باهتة. أمر غريب لا تضاهيه إلا غرابة التفسير المقدم: لقد هوجم الغيطاني لأنه «اختار أن يدافع عن الهوية العربية وأن يلتزم أخلاقية الكتابة»، ولأنه «يرفض التبشير الكاذب وتشويه الحقائق». تفسير لا يمكن أن يجيب عن أسئلة من نوع: إذا كانت الحملة تستهدف الصفتين السابقتين، فهل الغيطاني هو المثقف الوحيد الذي يتحلى بهما في الوطن العربي؟ وإذا لم يكن الأمر كذلك فلماذا الغيطاني دون غيره؟ هل المسألة شخصية بالقدر الذي يراد إظهارها به؟ وإذا لم تكن كذلك فأي أشياء تهدد هذه «الحملة» في العمق بتعريتها، بما يجعل إضفاء الطابع الفردي عليها طوق نجاة وحيد لإبقائها مستورة؟ ثم ماذا لو كشف المستقبل عن تلطخ أسماء ثقافية أخرى بمستنقعات صدام؟ هل سيطلع علينا هؤلاء المثقفون في كل مرة ببيان يدافع عن المتهم الجديد؟…
ولحد كتابة هذه الأسطر لا زال دفاع الغيطاني يصر على تكذيب أن يكون مؤلف «وقائع حانة الزعفراني» هو كاتب «زبيبة والملك». فقد ظهر يومه (03/06/2003) مقال يلخص مضمونه في عنوانه: «زبيبة والملك. لا أعتقد أن الغيطاني فعلها!!».
إذا كان بيت القصيد في القضية (من زاويتها الضيقة) – على نحو ما يبدو الآن على الأقل، إن أخذنا أقوال الاتهام والدفاع مجتمعة – هو (إثبات أو نفي) دليل تعامل الغيطاني مع الديكتاتور المخلوع، ألا يشكل كل من كتاب «حراس البوابة الشرقية» الحامل توقيع الغيطاني وأسفار الغيطاني للعراق دليلا – بديلا ماديا على هذا التعامل؟ لماذا هذا الإصرار، من لدن الغيطاني وأنصاره، على حصر القضية في مسألة تأليف كتاب أو كتابين في الوقت الذي يقوم صك الاتهام على مبدأ التعامل مع النظام العراقي، وهو ما يؤكده الغيطاني ضمنيا عندما يصرح بأنه كان يتردد على العراق إلى حدود سنة 1988؟ هل كان حكام العراق قبل هذا التاريخ ملائكة ثم تحولوا إلى شياطين؟ وبالمناسبة هل ثبات هذا التردد هو ما يفسر حصر البيان الحملة في نطاق الغيطاني أم أن البيان اتخذ ضمنيا من الروائي «المظلوم» مشجبا لتعليق / تأجيل (إلى تاريخ غير مسمى) كل حديث عن أسماء أخرى؟
– 4 –
يحدد المقال الصادر في «الإمبراطور»، بتاريخ 21 / 05 / 2003، تحت عنوان: «جمال الغيطاني من أصحاب السوابق!! ورواية “حراس البوابة الشرقية” دليل مادي بإدانته كمجرم حرب» السياق الذي تندرج فيه القضية، وهو ظاهرة محاكمة مجرمي الحروب التي اهتدت إليها المجتمعات البشرية غداة الحرب العالمية الثانية، والتي لم تطل العسكريين النازيين والفاشيين وحدهم بل، وكذلك الشعراء والكتاب الذين صفقوا للديكتاتوريات، إذ وضع الشاعر الأمريكي عزرا باوند في مستشفى الأمراض العقلية بواشنطن، بسبب نشاطه في إيطاليا الفاشية ودعايته لها، واتهم الشاعر النرويجي كنوت هامسون بالخلل العقلي وحوكم وأدين، كما وحوكم الكتاب المصفقون للرايش وتعرضوا للشنق… وإذا كان هذا الطرح يشكل تصعيدا في المسألة، فإن هذا التصعيد قد لا يجد مبرره سوى في عنف رد الفعل الذي صدر عن الغيطاني ودفاعه المتمثل في إدراج طرح مثل هذه القضايا ضمن دائرة العمالة و السلوكات البوليسية المشبوهة، والإساءة للعروبة والقومية ، الخ. وهكذا، بعد التقاط هذا العنف، يصوغ المقال صك الاتهام على النحو التالي:
«هنا.. نذكر الغيطاني – وقد لا يحتاج حتى إلى مثل موعظة التذكير هذه – عن مصير الأدباء والكتّاب، ممن ساندوا هتلر في حقبته النازية؟ ألم يحاكموا؟ ألم تذهب بهم كتاباتهم إلى المشانق، مثل قادة تلك الجيوش االذين نالوا العقاب في ساحات الإعدام ، بحيث كانت العقوبة شبه متعادلة ما بين من يقتل الآخر بالرصاص، وبين من يحرض على الموت المجاني تحت راية الرايخ الدموية؟!!
الغيطاني في العراق.. حرض رئيساً هو بالأساس من المصابين بهوس القتل. حرضه بامتياز. أو قدم له ما يبرر له شن تلك الحرب. ومن هنا.. يكون الحق لكل من فقد شهيداً من أهل العراق وإيران على حد سواء في حرب الخليج الأولى، مقاضاة الغيطاني، باعتباره كاتب محرض ومساند في أدبه لقائد القوات المسلحة صدام حسين!!
تهمة جرائم الحرب هنا، لا تنطبق على القاتل الذي يستعمل السلاح وحسب، بل إن الجريمة تشمل التحريض، كسلاح يقود إلى ارتكاب أعمال العنف والمجازر. والغيطاني متهم. وأهل الضحايا، وهم أكثر من مليوني قتيلاً، لديهم في رواية «حراس البوابة الشرقية» الدليل المادي لإنجاز التهمة وما يترتب عليها من استحقاقات في العقاب. هل في هذا ما يلومنا الغيطاني عليه؟ أم أن كتابة الروايات لع أولاد. كل واحد يكتب رواية أو قصيد، فيقبض مالاً، ثم يدير ظهره ويختفي عن المسرح؟!! »
وواضح أن وضع القضية في هذا المستوى يجعلها لا تهم الغيطاني وحده، بل مجموع المثقفين الذين صفقوا للديكتاتور المخلوع، مقدمين له سندا للممارسة جنون القتل ليس في حق الشعب العراقي فحسب، بل وكذلك في حق الشعب الإيراني:
«ما أكبر حاجة العراقيين إلى محكمة عدل أدبية، لمقاضاة كل من شارك بقتلنا وجلدنا ونفينا وتحطيمنا على مدار أكثر من ثلاثين سنة من الإبادة الشاملة. من التهم الزائفة. من الملاحقات عبر الحدود. لم نعد نحتاج إلى معلمين في الأدب والسياسة والوطنيات. ولا نريد أن نغمد رؤوسنا في الرمال إلى الأبد، فنترك المرتزقة من شعراء ونفايات أحزاب ورقاصات ورقاصين، يتمتعون بسحت النفط الحرام، فيما الملايين من العراقيين تشرب الماء الخابط بديدانه، وهم لا يعلمون بدخول العالم عصر الألفية الثالثة؟!! ».
لا يدخل هذا المطلب ضمن ما يمكن أن يثير استغرابا، لأنه يتوفر على شرعية ومرجعية؛ فهو صادر من جهة عراقية، من متضررين من النظام الأسبق، الأمر الذي يجعل المسألة أكبر من أن تكون مجرد تصفية حساب بين المثقفين، وشاهد الضرر آلاف ضحايا القمع من سجناء ومعطوبين ومدفونين مقابر جماعية ومشردين في بقاع العالم؛ ويتخذ له بمثابة مرجعيته ذلك الإنصاف الذي قامت به مجموعة من الشعوب غداة التخلص من ديكتاتورياتها. بكلمة واحدة إنه مطلب ليس شاذا في بابه، ولا يمكن لأي إنسان حداثي ونزيه ومتمدن إلا أن يتفهمه.
لكن ماذا حصل؟ في يوم 26/06/2003 تناقلت وكالات الأنباء (بما في ذلك فرانس بريس) خبر بيان مجلة «الآداب» (انظر أعلاه) متجاهلا هذا الطرح تجاهلا كليا، واضعا المسألة في سياق السعي للنيل من العروبة والقومية والوحدة العربية، وتكريس الهيمنة الأمريكية، إلى آخر الشعارات والاتهامات التي راحت حقلا لكل المزايدات، ثم حاصرا إياها فيما يبديها صراعا شخصيا بين الغيطاني ومثيري مسألة ضرورة محاكمة أدباء صدام ومثقفيه، ليغدو الحديث عن القضية «تبشيرا كاذبا» و«تشويها للحقائق» و«اتهاما لا يأتلف مع القيم الثقافية» و«قمعا للرأي بالنميمة والتشويه» وهجوما على «الثقافة الوطنية العربية» ممثلة في الغيطاني، مع ما يقتضيه ذلك كله طبعا من دفاع عن هذه الثقافة ممثلة في روائينا الذي صار هو هي وهي هو.
أن تحول مسألة علاقة مجموعة من المثقفين العرب بالديكتاتور المخلوع إلى ضرب من التابو والحقل الممنوع عن الكلام، بما يلازم ذلك من رفض للقيام بنقد ذاتي ومراجعة للمواقف واعتراف بالأخطاء وعزوف عن تنوير الرأي العام الثقافي العربي، فتلك صفعة كبرى توجه للثقافة العربية من قبل كبار مثقفيها وإهانة كبيرة للرأي العام الثقافي العربي من لدن كبار رموزه!!
ما ألفنا مثل هذا إلا من فقهاء الظلام والحكام المتسلطين!!
محمد أسليم – 03/06/2003
موقع محمد أسليـم، 06 يوينو 2003:
http://aslimnet.free.fr/articles/ghitani.htm
وفي موقع الإمبراطور:
http://www.alimbaratur.com/index.php?option=com_content&view=article&id=113:2010-08-22-12-20-19&catid=8:2010-08-07-22-19-55&Itemid=9
الكاتب: محمد أسليـم بتاريخ: الخميس 23-08-2012 02:54 صباحا