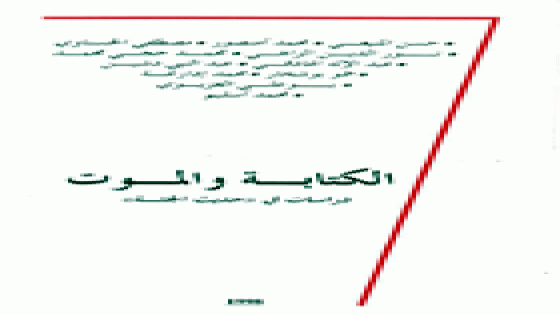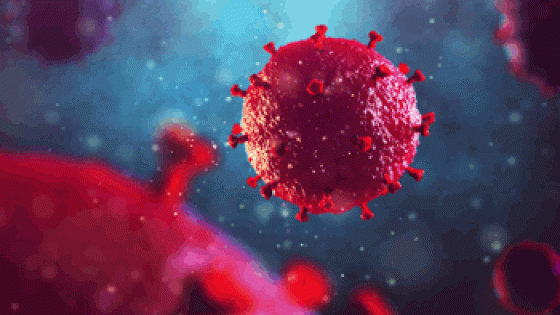جددتُ صلتي اليوم بمطعمي المفضل، بعد انقطاع عنه لمدة طويلة بسبب تقاعسي عن الخروج للمشي في النهار. وإذا كان لي أن أشكر أحدا لهذا التجديد، فلي أن أوجهه لصديقتين مكناسيتين، اختارتا لدى عودتهما من رحلة إلى مراكش، قبيل العيد الأضحى، قطع سفرهما في القنيطرة، فأقامتا في فندق، فحرصتا على لقائي، في مكان تصادف أنه كان قريبا جدا من المطعم، فكان أن تناولنا وجبة الغذاء هناك… راقني المطعمُ كثيرا للعناية الكبيرة التي أحاطه بها صاحبه، حيث جدَّد كل شيء فيه تقريبا، ما فتح شهيتي للرجوع إليه، وهو ما فعلتُ اليوم.
جلستُ في مائدة قصية بساحة المطعم، وفي انتظار أن يأتيني النادل بما طلبتُ استغرقتُ في تأمل تفاصيل ما استجد بعد غيبتي، فإذا بكل شيء أنيق فعلا، إذ نجح صاحب المحلّ في الموازنة بين توفير جمال المنظر وجاذبية المكان دون أن يصرف مبالغ كبيرة، ما مكَّنه من الحفاظ على أسعار الوجبات، المعقولة أصلا، والاحتفاظ بالزبائن القدماء، بل وربما جلب زبائن جدد، بخلاف جاره الذي تمادى في إهمال مطعمه، والزيادة في أسعار المأكولات والمشروبات، فعاقبه الزبائن بأن انفضوا من حوله، فلم يجد بدا من الإغلاق، رغم أنَّه كان أوروبيا أبا عن جد، ينيط مهمة قبض النقود بسيدة جميلة وأنيقة جدا، ويشغل نادلات صغيرات جميلات… ربما كان خطؤه القاتل أنه استغبى الزبائن المحتملين منذ البدء، إذ أطلق على محله اسما فخما مع أنه صغير لا يتسع لعدد كبير من الزبائن؛ كتب في أعلى واجهته بخط كبير: «سندباد: مقهى وصالون شاي ومطعم »!، ربما حسب نفسه جاء إلى إحدى قرى مالي أو الصومال، كما كان يتوهم الكثير من الفرنسيين، من قبل، أيام كنا طلبة في باريس، في منتصف ثمانينات القرن الماضي. كانوا يتخيلون أننا جئنا من الخيام ومن ظهور الجمال، فكان بعضهم يسأل بكل «براءة»، وبعضهم الآخر بنبرة مبطنة بالعنصرية والاحتقار:
– ما اسم عاصمة بلادكم؟
– هل تعيشون في الخيام؟
– هل تركبون الجمال؟
– ماذا تأكلون؟
– ماذا تشربون؟
– لماذا جئتم إلى هنا؟
وما إلى ذلك من الأسئلة السخيفة المقززة التي تسلينا غير ما مرَّة، إمعانا في إضفاء مزيد من العبثية على الحديث مع ذلك الصنف من البشر واللقاءات التهكمية، لكن أيضا لرد الاحتقار بالاحتقار، تسلينا بتقديم أجوبة مثل:
– إيه، والله، الأمر كذلك!
– عاصمتنا الرباط، تحيط بها الرمال من كل الجهات.
– نسكن الخيام، ونركب الإبل.
– نتوجه إلى الجامعة على متن البغال والحمير، وقبل الذهاب نحلب البقر، ونسوق قطان الماعز والإبل إلى المراعي، ونتركها هناك، ونرجعها إلى خيامنا في طريق عودتنا إلى الخيمة!
– جئنا إلى هنا لنتعلم الحسابَ، وتحرير عقود البيع، لنحسنَ تسويق جمالنا وحميرنا وبغالنا!»…
وعندما كان أحد أولئك البلداء يسأل:
– أين تقع الرباط؟
كان الجواب:
– على بُعد بضع كيلومترات من نواديبو.
أو يسأل:
– أين يقع المغرب؟
كان الجواب:
– جنوب مالي (أو شمال أوغندة)! …
وقد تكون الضربة القاضية جاءت صاحبنا النصراني ربّ المطعم من جهات لا يد لصاحب مطعمي فيها من قريب أو من بعيد:
فمقابل تسمية الأول مطعمه باسم استعاره من إحدى سلسلات الفنادق الراقية بأكادير، سمى الثاني محله «الموناليزا». ولم يكتف بالتسمية، بل وضع صورة كبيرة للموناليزا في جدار ساحته، وفيما كان يخيم على فضاء المطعم الأول صمت قاتل، تفنن صاحب المطعم الثاني في إمتاع زبائنه بأجمل أنواع الموسيقى الآلاتية. أكثر من ذلك، بينما يقع المطعم الأول في زاوية ملتقى طرق، تتوسط المحل الثاني شبه ساحة صغيرة فارغة، ومقهى اختار لنفسه اسما أنيقا، التصق هو الآخر بأحد أرقى ملاهي المدينة، يذكر سواد بابه بأمنيزيا الرباط، وها هو أحد خيوط الرواج ينكشف: المطعم قريب جدا من مكان للشراب واللهو! لا داعي لمن تهيأ (أو تهيأت) لصعود طائرة العقل، أو حتى حلق (أو حلقت) في الأجواء العليا، خصوصا في الليل، أن يجتازا «صراطا» لكي يصلا إلى مطعم «رامبو» القرن الواحد والعشرين! يستغنيان عنه بفضاء «الموناليزا» الذي حرص صاحبه على خلق الجو الآنف كله مع المواظبة على أداء الصلوات في أوقاتها في آن واحد، داخل المطعم نفسه… منتهى التعايش والتسامح! يتعايش الزبائن على أصنافهم في احترام متبادل لبعضهم البعض ويوفون طقس الأكل حقوقه وواجباته. فكل زبون وزبونة حر في سلوكه ومسؤول عنه، لكن لكل طقس مكانه. لا مجال للخلط بين هذا وذاك. وبذلك تجد الفضاء أحيانا خلاصة للمجتمع المغربي من حيث تنوع أصناف الزبائن…
*
* *
انهمكتُ في الأكل، وها هي امرأة عجوز تقف قبالة إحدى الموائد المجاورة لي، فوق رأس رجل مسن صاحب لحية قصيرة بيضاء وطاقية أيضا بيضاءمن النوع الذي يرتديه حجاج البوادي والمدن الصغرى ويتكرمون به على الأهل والجيران بعد عودتهم من الديار المقدسة، في حين ارتدى جليسه الشاب بذلة عصرية رمادية أنيقة ونظارتين طبيتين. كانت العجوز مرتدية جلبابا أسود وحذاء رياضيا، وقبعة رياضية حمراء، محيطة وجهها بفولار وردي تدلى إلى أن غطى نصف صدرها. كانت تبدو منهكة، تكاد تقوى على الوقوف، فاتحتْ جاريَّ، استعطفتهما كي يمنحانها فقط ما تيسر من الطعام لتسد به رمقها، لأنها جائعة جدا، لم تأكل شيئا منذ الصباح، وأنها على وشك الإغماء من شدة التعب والجوع ومرض القلب حسب ما قالت. ولتقديم الحجج والأدلة على مرضها، أخرجت من حقيبة يدوية قويت على حملها بالكاد دزينة علب أدوية مرض القلب والشرايين، وورقة قالت إنها لإجراء عملية على القلب في غضون يومين إلى ثلاثة على أكثر تقدير. وبما أنه سبق لي أن تناولتُ «جبالا» من أدوية مرض القلب، على حد تعبير طبيبي نفسه، أيام قضيتُ حوالي أسبوعين بقسم مستعجلات أمراض القلب والشرايين بأحد المستشفيات، بحيث صرتُ أعرف أسماء العديد من أدوية أمراض القلب والشرايين، فقد ألقيتُ نظرة على علب العقاقير التي أخرجتها المرأة، فإذا هي أدوية لا علاقة لها إطلاقا بأمراض القلب! أغرب من ذلك، فقد كانت العلب خليطا من منشطات جنسية ومسكنات لأوجاع الرأس ومراهم، وما إلى ذلك! فطنتُ إلى أنَّ المرأة، خلافا لمزاعمها، لم تكن سوى واحدة من هؤلاء المتسولين والمتسولات الذين يجيدون تمثيل أدوار البؤس واستدرار العطف في مسرحيات يتقنون كتابة سيناريوهاتها وإخراجها، والذين تمتلئ بهم المحطات الطرقية لنقل المسافرين، ووسائل النقل العمومي نفسها بما في ذلك القطار، إذ دأبت مؤخرا جماعة على الصعود من محطة تابريكت بسلا وعرض مسرحية الشحذ من سلا حتى مشارف القنيطرة بمنتهى الإتقان، فيزعم هذا أنه قد خرج من السجن للتو، وأنَّه لا يملك مليما واحدا للرجوع إلى مدينته، ويزعم ذاك أنَّ السبيل قد انقطعت به، بعد أن فقد أمواله وأوراقه خلال عودته من سفر إلى هذه المدينة أو تلك، لزيارة قريب له، وتخرج تلك دزينة من الأوراق زاعمة أنَّ والدتها مريضة بالسرطان، وأنها قد طرقت جميع أبواب المساعدة، لكن دون جدوى، فلم يبق أمامها سوى ملاذ واحد، هو ركاب القطار، بعد الله، على حد تعبيرها، وما إلى ذلك. بل رابطت إحداهن في المحطة الطرقية للمسافرين بمدينة الرباط سنينا طويلة تستجدي. كانت تأتي يوميا، وتصعد الحافلات واحدة واحدة قبل إقلاعها، فتزعم أن كل ما تحتاجه هو ما تسد به رمقها وتؤدي به ثمن الإقامة في نزل، لأنها سوف تجري عملية جراحية في غضون يومين بالمستشفى الجامعي ابن سينا. تعاقبت السنون، دون أن تجري عملية جراحية ولا هم يحزنون…
قلتُ ربما هذا بالضبط ما قامت – وتقوم – به عجوز اليوم. فهندامها يفضح احترافها التسول: القبعة الرياضية للوقاية من الشمس جراء قضاء وقت طويل تحتها، والحذاء الرياضي لقطع المسافات الطويلة مشيا على القدمين، وشدة التعب ووشك الإغماء المزعومان تبددا بمجرد ما حصلت العجوز من جاريَّ على ما أرادت. يبدو أن اللعبة انطلت على جاريَّ، أو تظاهرا بتصديق المتسولة: أعطياها صحني بطاطس مقلية، وقطعة دجاج مشوي ولحما مشويا، وزاداها السلطة التي كانت تشتمل على خضر وسمك وجبن أصفر ومايونيز، فحرصت على أن تسكب عليها مزيدا «المايونيز»، ثم طلبتْ ورق ألمونيوم، ولفت بداخله ما نالته، وانحنت لتدسه في حقيبتها التي حرصت على إخفائها تحت مائدة الجالسين، استرقتُ نظرة إلى ما بداخل الحقيبة، فإذا بها ممتلئة إلى النصف بسائر أنواع موبقات مرض القلب: نقانق، دجاج، لحم، لحم مفروم (كفتة) وسط أنصاف دوائر الخبز. أشفق عليها بعض الزبائن، سلموها بعض ما كانوا يأكلون، وضعت كل شيء في الحقيبة، وقفت، خطت بضع خطوات، اختفى تعبها، مشت مشية عادية، وقفت في مائدة قصية بالجهة المقابلة، وها هي تتماوتُ مجددا، وتستأنف عزف أنشودتها من جديد:
– أكاد أموت جوعا، لم آكل شيئا منذ الصباح، أنا على وشك أن يُغمى عليَّ. أنا مريضة بالقلب، ها هي الأدوية التي أتناول، سوف أجري عملية جراحية على القلب في غضون يومين، ها هي وثيقة المستشفى!…