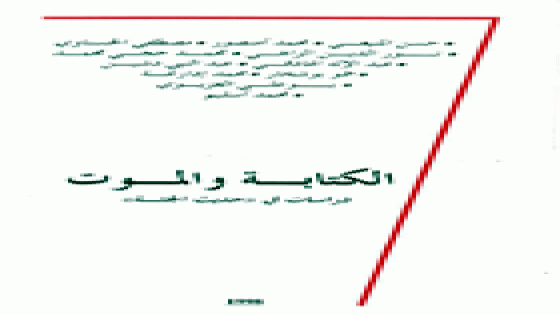هيمنت شبكة الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي على الساحة الثقافية العربية، فقدمت منتجات ثقافية جديدة مختلفة عن السائد لكنها أثارت موجات جدل واسعة من حيث القيمة والجوهر، وهو جدل خلخل البنى الراسخة للمنتجات الثقافية على تنوعها وتعدد أنماطها. وفي هذا الحوار مع الباحث المغربي محمد أسليم نقترب أكثر فأكثر من هذه القضايا خاصة وأن الرجل كانت له العديد من البحوث العميقة والمثيرة في هذا المجال
يعتبر محمد أسليم أحد الكتاب المغاربة الذين أغنوا المكتبة العربية بالعشرات من الكتب، فهذا الباحث غزير الإنتاج، خاصة وقد اخترقت أدبيته جغرافيا أكثر من جنس تعبيري، لتظل أغلب طروحاته النظرية وآرائه المنهجية محط نقاش واسع من طرف النقاد وجمهور واسع من المتتبعين للمشهد الثقافي، خاصة وأنه ينفتح على آفاق مخالفة ومستجدة في البحث والإبداع.
لك دراسات واهتمام بالغ بالأنترنت، ما الذي يشغلك في هذا الفضاء؟
مما يُلفتُ الانتباه التغيير الكبير الذي تجريه شبكة الشبكات، باعتبارها أحد مظاهر الثورة الرقمية أو نتائج «الانتقال من النسق الصناعي الميكانيكي إلى النسق الرقمي»، كما يطرحُ البعض. اهتمامي بالرقمية يقتصر على صعيدين: الثقافة، ثم الكتابة والقراءة.
بخصوص الثقافة، يبدو أنَّ الرقمية تشكل درجة أخرى في ارتقاء النوع البشري، بعدما ابتكره التقنية وولج عالم اللغة والرمز، ثم اكتشف الزراعة وتربية المواشي وغادر حياة الترحال إلى الاستقرار الذي أنتج حضارتنا الراهنة. الانتقال الجاري من العالم الواقعي إلى العالم الافتراضي ارتقاءٌ جديدٌ. على سبيل المثال، يجري الحديث حاليا عن أن ثروات الأمم لم تعد تقدر بعائداتها المادية الطبيعية، ولكن بما تملكه من معلومات ومعارف.، والانفجار التواصلي الذي نتج عن انتشار الشبكات، خارج قيدي المكان والزمان، إذ صار الجميع جارا للجميع، وصار الوقت شبه حاضر مُطلق، قد لا يُناظره إلا التحول الجيني الذي مكن الدماغ من أن يصبح أكبر حجما وأثقل وزنا، والآخر الذي أتاحَ ظهور اللغة المنطوقة.
على المستوى الكتابة والقراءة، إذا كان اكتشاف الإنسان للحروف الأبجدية قد شكل تقدما هائلا، حيث صار الإنسان قادرا على قول أفكاره وعواطفه وأشياء العالم الطبيعي بحفنة صغيرة من الحروف من خلال توليفها إلى ما لا نهاية، فقد أصبحت الآلة اليوم قادرة على قراءة جميع لغات العالم وعرض نصوصها على الشاشة، انطلاقا من بضع عشرات من الرموز لا غير، ما لا يستطيع أي فرد في العالم أن يقوم به. هذه أيضا درجة أخرى من التجريد قادت البعض إلى القول باختفاء الكتابة والبعض الآخر إلى القول باختفاء الكتابة والقراء معا.
ثمَّ مع شبكة الأنترنت أصبح بإمكان أي كان أن يكتب وينشر ما شاء بمجرد توفره على جهاز رقمي متصل بالشبكة، مما يُلغي سلسلة النشر التقليدية التي كانت تحول دون وصول النص إلى القارئ ما لم يجتز مجموعة من الحواجز. لهذا المستجد فضيلة وُصول الأعمال التي كانت تُقصى سابقا لسبب أو لآخر، فلا تصل إلى جمهور القراء، لكنه يجعل الكتابة فضاء مُشاعا يلجه الغث والسمين… ولهذا آثار كبيرة على قطاع النشر، والوضع الاعتباري للمؤلف، ومفهوم النص، والملكية الفكرية، وما إلى ذلك. وإذا أضفنا إلى ما سبق ظهور لون جديد من الكتابة لا يُغادر فيه النص الأدبي الحاسوب كتابة وقراءة، ما يؤشر على دخول الأدب منعطفا جديدا لا يتردد البعض في تسميته بـ «إبدال جديد»، اتضح أنَّ تركيز الاهتمام بالشبكة ليس مضيعة للوقت ولا ترفا فكريا، بل هو انخراطٌ في قلب مجموعة من التطورات الكبرى الراهنة.
نتكلم اليوم عن موت الكتاب لفائدة الأنترنت ؟هل انتهى زمن الكتاب ؟
يتألف الكتاب من جانبين: مادي، وهو هذه المجموعة من الأوراق التي يُضمُّ بعضها إلى بعض ثمَّ تُخاطُ أو تُلصقُ من أحد الجانبين، وهذه التقنية حديثة في تاريخ الكتابة الطويل، ظهرت في القرن II ق.م لا غير، بينما ظهرت الكتابة منذ حوالي 7000 سنة، ومعناه أنَّ الكتاب مجرد محطة في تاريخ الكتابة الذي تنقل بين عدة حوامل. أما الثاني، فيتمثل في كون تدوين المعلومات بالطريقة الآنفة هو أيضا تبويب وتنظيم وفهرسة لها بطريقة معينة، بل وكذلك هو طريقة في التفكير والاستدلال. استغرقت العمليتان قرونا عدَّة قبل أن تترسَّخا وتأخذا شكلهما النهائي مع اختراع المطبعة في منتصف ق XVم، ما أفضى إلى هيمنة الكتاب وولوج «عصر جتنبرغ». إلى هذين البُعدين يتجه القصدُ بفكرة زوال الكتاب. علاوة على ذلك، يُظهر تاريخ الكتابة والحوامل أنَّ الإنسان سعى دائما إلى تخزين أكبر عدد من المعلومات في أصغر حيز ممكن، وهو ما تحقق اليوم مع الحوامل الرقمية، إذ تبلغ السعة التخزينية لبعض أجيال الكتب الإلكترونية حاليا 500 ألف كتاب، ما لا يكفي عمرُ المرء كاملا لقراءته. كما أنَّ الحوامل الرقمية تخزنُ في مكان واحد وبصيغة واحدة (هي 0 و1) سائر أنواع الملفات: المكتوبة، والصوتية، والبصرية، والسمعية – البصرية. وحيثُ تلاميذ اليوم هم قراء الغد، فقد يؤشر إلغاء مجموعة من البلدان للكتاب المدرسي الورقي وحذف تعليم الكتابة اليدوية على دخول نجم الكتاب طور الأفول. قد يظهر بديل اصطناعي للورق الحالي، لكن ذلك لن يطيل عمر الكتاب لأن الأمر يتعلق بقضايا أكبر. فمع الحوامل الرقمية يجري تفكيك المكتبة والكتاب في آن:
باستشارة أي محرك للبحث حول موضوع ما، تعرض النتيجة مجموع صفحات الويب ذات الصلة بهذا الموضوع المتوفرة في الشبكة، بصرف النظر عن تخصصها ومكان وجودها. فشبكة الأنترنت بمثابة مكتبة هائلة بدون ترتيب ولا تنظيم، لكن عندما يطلب القارئ كتابا أو نصا في موضوع ما، توضع أمامه، وبسرعة قصوى، سائر المستندات المتصلة ببحثه… أما الكتاب، فيجري تفكيكه في اتجاهين: الانتقال من الكتاب إلى المتن، حيثُ بات بالإمكان البحث، بواسطة برامج معلوماتية متخصصة، في تواتر مفردة أو سلسلة كلمات في قواعد بيانات تشتمل على آلاف الكتب، كما يتم الانتقال من الكتاب إلى المقطع، من الطريق الآنفة أو بواسطة ما يُسمى بـ «القراءة التشعبية».
ثمَّ من خلال قدرة الحوامل الرقمية على تخزين سائر أنواع الملفات بصيغة واحدة وفي حيز واحد، تأخذ الكتابة عامَّة في أيامنا هذه منحى التهجين، إذ تتكاثر النصوص التي تجمع بين الكتابة والصورة والصوت. وبما أنَّ معظم أطفال اليوم (قراء الغد) يستعملون الأجهزة الرقمية منذ سن مبكرة، فقد تفقد النصوص الخطية جاذبيتها، ما لم يكن هذا الفقدان قد بدأ بالفعل، إذ يحتاج الصغار بشكل متزايد إلى نصوص تتجه إلى أكثر من حاسَّة واحدة، وهذا أحد أسباب معضلة التدريس اليوم.
على أن هذا الاختفاء لن يتم فجأة. فبالرجوع إلى تاريخ الكتابة والحوامل، يتضح أنَّ ظهور حامل جديد لا يؤدي إلى اختفاء الحوامل السابقة كليا، إذ لا زالنا اليوم نكتب على المعادن والثوب والحجر والخشب، وما إلى ذلك، كما أنَّ إطاحة حامل جديد بالحامل السائد استغرقت دائما وقتا طويلا. على سبيل المثال، تطلب استبدال لفافة البردي بالدفتر ستة قرون. لكن بما أنَّ كل ما حولنا يتغير بسرعة مُذهلة في أيامنا هذه، فقد يتراجعُ الورق ُفي غضون بضعة عقود لا غير.
بعيدا عن أراء بعض النقاد الذين يرون نفس طرحي، أنت كاتب صعب التجنيس أو التموقع، أجد صعوبة كثيرة في وضع كتاباتك في خانة معينة؟ لماذا هذا الانفلات؟وكيف تجده من منظورك الشخصي؟
إذا تعلق الأمر بتعدد الانشغالات، فالحُدود بين العلوم والمعارف وأنواع الخطاب عامة هي أسياجٌ اصطناعية حديثة. ففي القديم، كانت الملاحم تشتمل على العلوم والأداب والتاريخ الأديان وسائر إنتاجات العقل البشري في نصّ واحد. بدأ الفصل مع اليونان لا غير، لكنه تواصل بتقدم الزمن إلى أن بلغ ذروته في ق. XIXم، ثم تسارع إلى أن أصبحَ الحقل الواحد ينقسم إلى عدة تخصصات فرعية لا يعرف المتخصص في أحدها شيئا عن التخصصات المجاورة له مع أن الجميع يشتغل داخل حقل معرفي واحد. فيما يخصني، أنفر من التخندق في حيز ضيق، لاسيما أنَّ الإنسان يبقى محور سائر أنواع التخصصات حتى ولو كانت الفيزياء الفلكية… أما إذا تعلق الأمر بالكتابة الإبداعية، فتجنيس الخطاب يتم بالنقد، وهو لاحقٌ على الإبداع وليس العكس. ثم، أظُّنُّ أن من حق المرء أن يكتبَ ما يشاء وبالشكل الذي يشاء إذا لم يعثر في الأنواع المبوَّبة ما يُناسِبُه، لأنَّ اللغة فضاءٌ رحبٌ يتسع لما لا يحيطُ به التقعيد.
أنت من المولعين بمجال الترجمة، كيف ترى وضعية الترجمة اليوم داخل المشهد الثقافي؟
وضعيتها متردية جدا حسب الإحصائيات. ويعود ذلك إلى كون هذا النشاط يبقى مجهودا فرديا على العموم، وغياب قاعدة قراء واسعة في الوطن العربي، وأخيرا غياب ما يُمكن تسميته بـ «سياسة للترجمة» في أي قطر عربي. وحتى في حالة وجود هيئات حكومية، ومبادرات رسمية لاستدراك الأرقام المخجلة للمنجز الترجمي العربي، فإن هذا النشاط لا يؤتي أكله، إذ لا سبيل لذلك إلا بتعميم التعليم وإيجاد قاعدة قراء واسعة أوَّلا، ثم وضع إستراتيجية للترجمة مبنية على أسئلة مثل: ماذا نترجم؟ لماذا؟ لمن؟ وكيف نضمن الحصول على تأثير لما يُترجم؟ وكيف يمكن قياس هذه المردودية ؟
الكتابة والدراسة في موضوع غائر وملغز كالسحر شغلك لفترة، وأخذ من طاقتك الكثير، ما دواعي هذا الانشغال بهذا الموضوع؟
قد يكون السبب البعيدُ تحذيرا كنتُ أتلقاه من والديّ في صغري: «إن يكلمك شخص غريبٌ في الشارع، فإياك ثم إياك أن تُجبْه. فأنت «زُهري» (الكَفَّين)، والسحرة يختطفون الأطفال «الزُّهريين»، يذبحوهم، ثم يستخرجون بهم الكنوز من تحت الأرض!». لاحقا، اشتغلتُ في هذا الموضوع بحثا عن جواب عن السؤال الذي يطرحه سائر الناس، وهو «هل السحر موجود؟»، لكن باتساع الاطلاع على ما كُتبَ في السحر والخفي عامّة، محليا وفي مجتمعات كثيرة متنوعة، بما فيها الغربية، تبيَّن سذاجة مثل هذا السؤال أو على الأقل لا جدواه، لأن الأمر يتعلق بإحدى الممارسات الكونية المنتشرة في الزمان والمكان، في سائر المجتمعات بدون استثناء، ومن ثمة بدل التساؤل عما إذا كان السحر حقيقة أو وهما، اللائقُ هو تفسير فعاليته. وبالإنصات إلى ما يقوله المسحورون، والاطلاع على طقوس السَّحرة، يبدو أنَّ الأمر يتعلق بتدخل اللغة والرمز.في حقل تقاطعٍ لأسئلةٍ أرقت الإنسان منذ القدم ولازالت، كالموت والجنس والمرض والجنون وما إلى ذلك، كما يتضحُ أنَّ السِّحرَ قادرٌ على مواكبة التطور وتغيير لغته وتدخلاته. في المغرب، مثلا، احتفظ السحر بخطاطته الكونية (لا يتسع المجال لذكرها) مع تطعيمها بعناصر دينية ليُشَرعِنَ نفسَه، ولكنه أصبح يضطلع بوظيفتين جديدتين في سياق تحول المجتمع والعائلة المغربيين منذ اتصالهما بالغرب إلى اليوم، وهما ترميز التوتر بين الحداثة والتقليد، ثم المحافظة على التقليد، ما يفيد ثباتا في الإطار وآليات الاشتغال، وتنويعا في «التوابل»، إن جاز التعبير، وأحيانا حتى في شخوص أطراف العملية السحرية. على سبيل المثال، ظهر سحرةٌ وقراءٌ للغيب يستغلون وسائل الإعلام الحديثة، وآخرون يتخذون من محلات بيع عقاقير العلاج الطبيعي واجهة لمزاولة هذا النشاط الذي لا يَحظى بقبول اجتماعي صريح.
ما السر وراء اقتران اسم المغرب بالسحر لدى البعض ؟
المشارقة هم الذين يحملون هذه الصورة ويروجون لها، ويمكن تفسير ذلك بأمرين. الأول: أظهرت بعض الدراسات في السحر أنَّ الساحر في العديد من المجتمعات هو الآخر: هو الحدَّاد عند البعض. وفي المغرب، هو من له علامة جسدية، واليهودي، و الفقيه المنحدر من منطقة سوس، وما إلى ذلك. هذا هو إطار نظرة المشارقة للمغاربة، ولكنها تمتح أيضا من عناصر تراثية، ككتاب ألف ليلة وليلة. أما الثاني، فهو دور الإعلام المشرقي في ترويج هذه الصورة الخاطئة. لو كان للمغاربة عدد ما للمشارقة من قنوات فضائية وانكبوا على محو هذه الصورة لتأتى لهم ذلك. علما بأن المغاربة بدورهم يعتبرون المشارقة سحرة، بل، معظم المصنفات السحرية التي يستعملها السَّحَرة المغاربة ألفها مَشارقة، كالبوني وعبد الفتاح الطوخي الفلكي، وغيرهما.
كيف ترى للساحة الثقافية المغربية اليوم؟ هل تعيش مناخا صحيا؟
خارج بعض مكونات هذه الثقافة التي لا أعرف عنها الكثير، كالمسرح والرقص والموسيقى والتشكيل والحفريات، وما إلى ذلك، تجتاز الثقافة المغربية تحولا كبيرا جراء المد الرقمي، ويتحلى ذلك في ثلاثة مستويات على الأقل:
مكّنت سهولة النشر الرقمي المتحررة من قيود الورق المادية والمؤسسية أعدادا كبيرة من ولوج الحقل الأدبي والفكري، ويتجلى ذلك في كثرة ما يُنشر في سائر أنواع المنابر الرقمية. وهذه الظاهرة صحية للغاية، إذ نجحت أسماء في استقطاب عدد كبير من القراء والمتتبعين دون أن يكون لها حضور سابق في النشر الورقي والمؤسسات المعروفة، بل هناك من بدأ النشر في شبكة الأنترنت، ثم وصل إلى الورق. ودورُ الرقمية هنا أيضا هامّ لأنها مكنت من تخطي الوسطاء المحليين. كذلك، سهل الفضاء الرقمي التواصل بين الكتاب والقراء المغاربة ونظرائهم في المشرق العربي والمَهاجر في شتى بقاع الأرض، فتأسست شبكة من العلاقات خارج المؤسسات الرسمية.
أيضا، استفادت الثقافة الشعبية من شبكة الأنترنت، فعرفت صُعودا بحلة جديدة، حيث يُنتج العديد من الشباب أشرطة من كافة الأنواع (فكاهية، ساخرة، غنائية، وما إلى ذلك) ويرفعونها إلى موقع يوتوب. ومن هؤلاء من يحظى بتلق واسع كما تشهد بذلك عدَّادَات الزيارات، إذ يستقطب الشريط الواحد مئات آلاف المشاهدات فيما لا يتجاوز سحب الكتاب المطبوع 3000 نسخة في أفضل الأحوال لا تنفذ أحيانا إلا بعد عقود.
أخيرا، مِثلَ ثقافة سائر المجتمعات، تعرف الثقافة المغربية اليوم مُستجدّ ما يسمى بـ «الثقافة الشبكية» أو «السيبرانية»، وتتجاوز الثقافتين العالمية والشعبية من حيث المكونات، لكن أيضا من حيثُ كونها طريقة في
الحضور في العالم، وشكلا جديدا من الوجود
عن موقع الموجة:
كتبت بواسطة : محمد سناجلة 25/04/2017