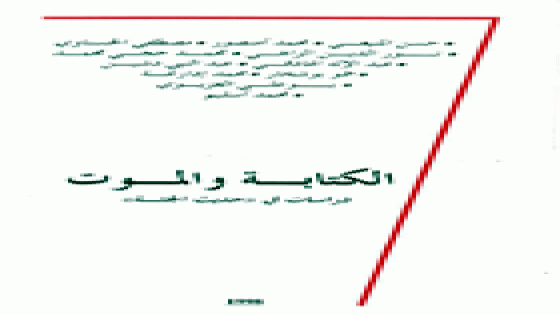عملا بمقولة المذهب الذي اعتنقته منذ نعومة أظافري، وهو: «عندما يتعلق الأمر بقضاء غرض إداري مَّا، يقف حماري دائما في العقبة، لذلك لا تطأ قدمي بابها إلا للضرورة القصوى»، فقد أجلتُ منذ مطلع العام الحالي إعداد وثائق إدارية لاسترجاع بقشيش من إحدى الإدارات. المبلغ ليس كبيرا، لكنه يمكن أن يسدَّ بعض الثغرات. كنتُ أجلتُ إجراءات استخلاصه رغم إصرار أحد أصدقائي الأعزاء هنا وإلحاحه علي بضرورة أن أقوم بذلك منذ مطلع العام الحالي أو قبله بقليل. أجَّلتُ الأمر إلى أن ألح عليَّ صديق عزيز آخر هنا، وأصر في الإلحاح هو الآخر مشكورا، في يونيو المنصرم، إلى أنْ استسلمتُ، فشرعتُ في إعداد الوثائق اللازمة، ولكن في إحدى عقبات الرحلة، وقف حماري، فتراجعتُ، وأبقيتُ الأمر معلقا إلى أجل غير مسمى، فكان أن داهمني خصاصٌ في هذه الأيام، فقلتُ:
-حسنا فعلتُ بتأجيل ذلك الأمر، هيا نستعيد بقشيشنا من الإدارة ونسد به هذا الثقب!
ثم عزمتُ وتوكلت على الله، رغمَ ما يمكن أن يحف بالأمر من مشقات جسام أحيانا، إذ تذيق إدارتنا عموما المواطن صنوف عذابات الانتظار والذهاب والإياب، ولزوم ما لا يلزم من الأوراق، وما إلى ذلك. تفعل الإدارة ذلك عندما تكون هي الرابحة، بمعنى عندما تكون أنت من سيدفع لها مالا، فما أدراك عندما يتعلق الأمر بالعكس، فتكون هي من ستسلمك بقشيشا؟ يلزم أن يكون على رأس هذه الإدارة وزير ملتحي عنيد، كرئيس الحكومة السابق، لكي تصبح مؤسسات الدولة عملية وفعالة بقدرة قادر، فتنجز المهمة بسرعة البرق: لم يكلف اقتطاع إصلاح صندوق التقاعد سوى كبسة زر على لوحة مفاتيح حاسوب وزارة المالية، بأمر من الوزير الملتحي، وها هي أموال مئات آلاف الموظفين تتدفق من رواتبهم وتصب في بحر الإدارة الأعظم القادر على ابتلاع كل شيء…
لهذا السبب استغنيتُ دائما عن التردد على الست الإدارة، مهما تزينتْ وتجملت وتعطرتْ. لا أثق فيها على الإطلاق! كان آخر الاستغناءات تماطلي أربع سنوات في تجديد بطاقتي الوطنية لإثبات عنوان سكني الجديد. وما كان ذلك التجديد ليتم لولا أن استرجاع «الثروة المفقودة»، الذي نحن بصدده الآن، يقتضي أن تتضمن البطاقة الوطنية عنوان السكن الفعلي. آخر هذه الاستغناءات أيضا أني لم أجر وراء مليم واحد من تعويضاتي المستحقة عن الدروس التي ألقيتها في بعض المواسم الجامعية، في مؤسسة أخرى، استجابة لطلبات أساتذة من أعز أصدقائي، فقدمت الدروس مجانا، بل تكرمتُ وأعفيتُ الطلبة من استنساخ الدروس بأن وزعتُ عليهم مطبوعاتها مجانا، فاجتنبتُ بذلك صداع رأس إعداد وثائق طلب التعويضات، مع ما يقتضيه ذلك من تنقل بين بنايات وإدارات لاستلام البقشيش. استغنيتُ عن ذلك بأن قلتُ:
-إذا كان الأمر هكذا، ويقتضي كل هذا التعب، فأنا على أتم الاستعداد أن أؤدي من جيبي معادل ما كنتُ سأستلمه، بل وحتى ضعفه إذا لزم الأمر، مقابل أن أقعد في بيتي فأربح وقتي وراحتي وصفاء ذهني!…
وآخر أواخر الاستغناءات أني لم أدفع الكثير من الملفات الطبية ووصفات الأدوية، لإدارة «الكنوبس»، من أجل استرجاع قسم مما تمَّ إنفاقه! ولي في ذلك أعذارٌ شتى (عدا العذر الرئيس وهو الخوف من الإدارة) يطول شرحها…
تعلق الأمرُ هذه المرة بتهييء ملف كبير، محطته الآن الحصول على شهادة السُكنى التي كنتُ استملتها قبل حوالي خمسة أشهر، في سياق تجديد البطاقة الوطنية… آنذاك، ذُهلتُ للسرعة التي تمَّ بها التجديد، إذ لم يتجاوز أسبوعا واحدا، كما لم تتطلب شهادة الإقامة أكثر من ترددين على الإدارة: خُصِّصَ اليوم الأول لمعرفة قائمة الوثائق المطلوبة، وكانت كلها معي، فتم إيداع الطلب على الفور، والثاني لاستلام الوثيقة، وهو ما تمَّ بالفعل، ما جعلني أشعر غير ما مرة بالذنب، وأقول:
-لقد تغير العالم كثيرا! كم كنتُ مخطئا في حق الإدارة وظالما لها!
لكن التوجس منها ظل مستيقظا بداخلي دائما ومستعصيا عن الترويض؛ لأنه يسهل سن قوانين إدارية جديدة، وإرسال مذكرات تلزم موظفي هذه الإدارة أو تلك بالانصياع لأخلاقياتها الجديدة، كما يسهل تغيير الأزياء والبنايات، لكن يصعب جدا تغيير الذهنيات. أحيانا، يتضح أنَّ قسوة المخزن تكون أهون بعشرات المرات من شطط أشخاص يمكن أن تصادفهم في الإدارات، والطرقات، وآخرين بين أهلك وأقاربك، وجيرانك، وزملائك في العمل… يلزم عقودا، بل ربما قرونا، لاستئصال خشونة البداوة القابعة في نفوس معظم الناس وعقولهم منذ عشرات القرون!
اليوم الأول:
معَ أنّ المنطق يقتضي الإعفاء هذه المرة من تحضير كل الوثائق التي قدِّمتْ في المرة السابقة، للحصول على الوثيقة نفسها، فإني لم أنسق وراء هذا الاستدلال. ظل توجسي مستيقظا. قلتُ لازم أروح مجددا، وأستفسرهم على الأقل عمَّ إذا كان من الضروري أن أعد ملفا جديدا ما دامت الوثائق التي أدليتُ بها قبل بضعة أشهر محفوظة في الأرشيف، فذهبت ومعي الأوراق الإدارية التي قدمتها سابقا.
لم يتضح أن توجسي كان صائبا فحسب، بل وجدتُ ما هو أكثر، وهو أن الإدارة قد أضافت وثيقتين جديدتين إلى قائمة الوثائق التي أدليتُ بها سابقا، فعدتُ إلى البيت خائبا، وأعددتُ الوثيقة الجديدة، ثم رجعت في اليوم الموالي.
اليوم الثاني:
بخلاف يوم أمس، حيث لم يكترث أحدٌ لدخولي إلى البناية، ولا اهتم بوجودي، فدخلتُ وجلستُ وتخلصتُ من تجاهلهم لي بأن قمتُ واصطففتُ وراء شخصين أو ثلاثة، إلى أن حان دوري فاستفسرتُ الموظف، واستجاب…، بخلاف ذلك، ما إن وطأت قدمي باب البناية اليوم حتى تلقفني شرطيٌّ مسنٌّ، وسألني بأدب:
-ما تريد يا سيدي؟
-إيداع ملف طلب الحصول على الوثيقة الفلانية.
-حسنا، اجلس هناك! (مشيرا إلى قاعة الانتظار الصغيرة التي لا تسع لأكثر من عشرة أشخاص).
لفت انتباهي حسن استقبال الموظف، فسرته باعتباره تطبيقا للشعار المكتوب على واجهة البناية: «نحن هنا في خدمة المواطن»، استبشرتُ خيرا، فإذا بالعكس سيتضح في اليوم الموالي…
قاعة الانتظار عبارة عن بهو صغير من بناية الإدارة التي يوحي كل شيء بأنها كانت في الأصل عبارة عن إقامة (فيللا) أو أنها تنحدر من أيام الاستعمار، وهذا عندي أرجح، إذ تتوسط البناية الصغيرة مساحة شاسعة فيها أعشاب ونباتات وأشجار كبيرة، محاطة بشباك حديدي، فبدت البناية بصغرها نشازا أمام الزحف العمراني الكاسح الذي تعرفه هذه المنطقة من المدينة، حيث تتسابق وتتقاتل حيتان أربعة ضخمة على اقتناء البقية المتبقية من الإقامات والمنازل والأبراج القديمة، فتستأصلها وتُحِلّ محلها بنايات عصرية شاهقة العلو، تحمل لمسات آخر طراز هندسة الحداثة، وأحيانا حتى ما بعدها، فكان من الطبيعي أن ينتقل هذا النشازُ إلى عقر دار البناية فيُشاهد بأم العين داخلها:
فقبالة قاعة الانتظار التي يبدو أنها كانت في الأصل غرفة صغيرة، ثم هدِّمَ أحد جدرانها، فصارت كبهو، لا يتجاوز عدد كراسيها أحد عشر، قبالتها توجد قاعة أخرى كبرى امتلأت عن آخرها بصناديق خشبية تشبه قمطرات اكتظت بالملفات التي يودعها المواطنون للحصول على هذه الوثيقة أو تلك مما يدخل في اختصاصات هذه الإدارة، وكُتب في واجهة كل صندوق الحرف الهجائي الأول من أسماء أصحاب الملفات بالحروف اللاتينية: ألف، باء، تاء، وما إلى ذلك. ومعنى ذلك أن الموظف الجالس وراء كونتوار هذا الأرشيف يستلم الوثائق، ويسلمها إلى موظف أو موظفة أخرى في إحدى الغرف بداخل البناية، فتُدخل المعلومات في جهاز حاسوب، ثم تُحفظ الوثائق في الأرشيف. مشهدٌ ذكَّرني بأول مصلحة عملتُ فيها، في منتصف ثمانينيات القرن الماضي، ثلاثة أشهر لا غير ثم قدمتُ استقالتي. كانت تلك الإدارة اسما على مسمى، وكانت توجد في أحد أرقى أحياء مدينة الرباط…
يومئذ، فرحتُ غاية الفرح بنجاحي في الحصول على وظيفة، رغم أنها كانت متواضعة جدا. قلتُ: سوف يتأتى لي تحرير رسالتي الجامعية في جو من الهدوء والصمت. كيف لا، والعمل لا يتجاوز الجلوس في مكتب بجانبه صندوق خشبي مثل هذه القمطرات، لكنه كبير جدا، كدستْ بداخله مئات ملفات الموظفين، مرتبة بأرقام. تأتي إلى مقر العمل في الصباح، وأنت وحظك: قد يضع العون أمامك سبع وثائق قد يضع عشرين، قد يضع خمسين وقد يضع ستين، ثم يمضي، فتبحث عن سجل صاحب كل وثيقة، فتدون في بطاقته المعلومات التي جاءت بها ورقته: هذا الموظف اغتصب صبية فسُجن، ذاك طلق زوجته، الآخر سرق معدات مقر العمل، هذا ألقي عليه القبضُ وهو سكرانٌ، ذاك رقي إلى الدرجة الفلانية، الآخر انقطع عن العمل فتم عزله، هذا ازداد له مولود، وذاك انتقل من المدينة الفلانية إلى المدينة العلانية، وما إلى ذلك… وبمجرد ما تنهي من إدخال البيانات في ملفات أصحابها يكون عمل يومك قد انتهى. أنت وحظ يومك: يمكن ينتهي في ربع ساعة، كما يمكن أن يستغرق ساعتين، بل يمكن ألا يأتيك العونُ بأي وثيقة، فيكون نصيبك اليوم كله، ولك أن تفعل به ما تشاء؛ نم أو اقرأ، أو اكتب، أو اسمع موسيقى، لا أحد يلومك أو يعاتبك. لكن يُمنعُ عليك منعا قاطعا أن تغادر البناية ولو لدقائق: الحارسُ واقف في بابها يترصد كل من سولت له نفسه الفرار! صَرفتُ الأسبوعين الأولين في قراءة ما كنتُ أصطحبه معي من كتب في جو هادئ صامت، كأن زملائي وزميلاتي كانوا مومياءات محنطة من حولي، فيما بعد اتضح أنهم كانوا مجرد ممثلي مسرحية أمام القادم الجديد الذي كنتُ إياه، إذ ما إن ألفوا وجودي حتى أطلقوا عفاريتهم من قماقمها، وها هي القاعة تضج بالضحك والصراخ وتبادل النكت والأحاجي وأحاديث وجبات الأكل في مطاعم وسط المدينة، ومحلات تخفيضات أسعار الأحذية والبدلات، وما إلى ذلك، مما استخلصتُ معه أنه سيكون من سابع المستحيلات عليَّ أن أقرأ كتابا واحدا في الشهر، فأحرى أن أحرر فقرة من أطروحتي إذا ما بقيتُ هناك، فصعدتُ إلى المسؤول الكبير ووضعت طلب استقالتي…
انتشر خبر استقالتي في البناية كالنار في الهشيم. الكثيرون هنأوني، لكن أحدهم، كان محرِّرا مثلي، كاد أن يأكل رئتيه حنقا وحسدا مع أنه كان من سكان حيي. في اليوم الموالي، بينما كنتُ عائدا إلى الحي كان صاحبنا خارجا منه. كان يحمل بين يديه مولوده المريض، متجها به إلى المستشفى، ومع ذلك استوقفني:
-قل لي، هل قدمت استقالتك فعلا؟!
-نعم
-ولماذا؟
-لأنني اجتزتُ مباراة أخرى، نجحتُ فيها، وسألتحق بعمل جديد…
-ما هي؟ ما هو؟ متى؟ أين؟
-…
فقد صاحبنا صوابه، انتابته نوبة هستيرية. أحمد الله لأنه لم يخطر ببال صاحبي أن يرمي في غمرة هيجانه ابنه عليَّ، فيقع المولود على الأرض، ويموت، فيتهمني بقتله كما تفعل الكثير من نساء البوادي للإيقاع بأعدائهن والزج بهم وراء القضبان عشرات السنين. صرخ في وجهي بأعلى حنجرته:
-أنتَ لصٌّ! أنت نصَّابٌ!…
نظرتُ إليه مشدوها، أعاد الصراخ في وجهي:
-نعم أنت لصٌّ! اشتغلتَ فقط ثلاثة أشهر، ووضعتَ راتب الأشهر الثلاثة في جيبك، ثم قدمتَ الاستقالة، وهربتَ! أعد للدولة ما أخذتَ منها! يجب أن تُرجعَ للدولة ما سرقتَه منها! أنت أكلتَ الدولة!!
كتمتُ ضحكة ساخرة مُرَّة، ثم واصلتُ سيري تاركا إياه يصرخ من ورائي وهو في حالة يُرثى لها…
هذا ما كنتُ أفكر فيه وأنا أتأمل الأرشيف تارة، وأرضية قاعة الانتظار تارة أخرى. بدت هذه مثل إصطبل جراء وسخ بقايا أقدام من مروا منها في هذا الصباح. فالأرصفة المحيطة بسور البناية كلها غير مبلطة، وتقع أسفل الأشجار الباسقة التي تكاد تحاذي السور… وبما أنَّنا في فصل الخريف، فقد بدأ ندى الأشجار يقطر فوق الأرض، فيبلل التراب إلى أن يصير بمثابة وحل يعلق بأحذية كل من مر فوق تلك الأرصفة التي لا سبيل للمرور غيرها، وإلا فامتطاء مروحية هو الحل! وفي غياب وجود منديل منشف أو بساط لمسح القدمين في مدخل البناية، كان من الطبيعي أن تتحول ساحة قاعة الانتظار الصغيرة إلى شبه إسطبل… غير أن الله وحده أعلم بسر بقاء أرضية باب البناية، والممر، وسائر مساحتها نقية، باستثناء غرفة الانتظار: هل لأن الموظفين حرصوا على إيثارها بالتنظيف دون غرفة الجلوس أم لأنَّ طالبي الوثائق كانوا ينتقمون سرا من الإدارة بتدنيس مكان جلوسهم الذي لا يوجد في مرمى عيون موظفي البناية بخلاف باقي الأقسام، فيحكُّون قيعان أحذيتهم فوق الأرض حَكَّا؟
لم أفطن لمرور الوقت. انهمكتُ في قراءة كتيب «حدود الذاكرة الاصطناعية. عن ضرورة النسيان» (بالفرنسية) الذي زهد مؤلفه (أو مؤلفته) في إثبات اسمه، مع أن الكتيب، على صغره، هام وفي غاية الفائدة. توغلتُ في القراءة، انتشلني صراخُ الموظف الذي سبق أن استقبلني بأدب واحترام. كان يصرخ في وجه امرأة التحقت للتو بالقاعة:
– لماذا فعلت كذا؟ وكذا؟!
– ….
– اسكتي، والله إنك لـ…
– ….
وما إلى ذلك. كانت المرأة ترتدي جلبابا، وفولارا، حاولتْ أن تُخلل «نشيد الموظف الحربي» بإدراج لازمتها، لكي تستقيم الأغنية، لكن بدون جدوى، إذ ما إن كانت تنطق بـكلمتي «المحكمة»، و«وكيل الملك»، حتى يواجهها الموظف بالصراخ:
– لماذا قمت بـ (كذا)؟! لماذا فعلتِ (كذا)؟!
فجأة ساد الهدوء. التحق الموظف بالباب، بدت على محيا المرأة علامات إشباع وارتياح كبيرين، إذ أزاحت الفولار كله من فوق رأسها إلى أن سفر شعرها كاملا، ثم أعادت شده ببطء. لم أعرف أكان لي أن ألوم الموظف على قسوته مع تلك المرأة أم ألوم السيدة نفسها على وقاحتها المفترضة، لأني لم أعرف تفاصيل الحكاية أصلا، ومع ذلك ملتُ إلى لومها، بحجة ظهور علامات الارتياح والانشراح على محياها بعد أن تلقت سيلا من التوبيخات والتقريعات. قلتُ قد تكون هذه المرأة من أحد صنفين من الناس:
فإما أنها من نوع ذلك الأستاذ الجامعي الذي كان يعرقل اجتماعات زملائه، إذ يعلق على الشاذة والفاذة، ويعترض من أجل الاعتراض إلى أن يفقد الاجتماع بوصلته، فلا تستقيم له وجهة، فيقنط زملاء الأستاذ، ويستعجلون مغادرته للاجتماع، لكنه يصر على البقاء ولا ينصرف، إلى أن يقوم أحدهم يقوم ويصرخ في وجهه:
– صه أيها الحمار! صه أيها الحمار!
وآنذاك فقط تنزل الراحة والسكينة على صاحبنا، إذ بمجرد ما يسمع هذه الكلمة ينكمش في كرسيه ويستسلم للنوم اللذيذ، إلى أن يوقظه زملاؤه لحظة انتهاء الاجتماع واستعدادهم لإخلاء القاعة!
أو أنّها ( = المرأة) من صنف جاري الذي أوسعني شتما ولوما في منتصف ثمانينيات القرن الماضي، لمجرد أني استقلتُ من وظيفتي بعد مزاولة لم تتجاوز ثلاثة أشهر، كأنني سرقتُ ضيعة أبيه أو نهبتُ ثورته!
ثم ربما كان الموظف أدرى بما يفعل. وكما كتبتُ في إدراج سابق:
فمن الناس من لا يهدأ له بال ولا يشعر براحة ما لم يتقدم إلى المحكمة أو إلى أقرب دائرة شرطة إلى بيته لكي يرفع دعوى أو يضع شكاية بغيره، كائنا ما كان هذا الغير: جاره، شريكه في التجارة، قريبه، وما إلى ذلك. والويل كله لمن وضعته الصدفُ في طريق هذا النوع من البشر!
راودتني فكرة أن أقوم وأسأل الموظف عمَّ إذا كانت المرأة بالفعل واحدة من هؤلاء الناس. إن قال نعم، أعطيتُه الفتوى التي نشرتُها في الإدراج سابق، وهي:
أن تتولى السلطة أو أقارب الواحد من هؤلاء الناس أمر صنع لوحة معدنية نحاسية، يُكتب عليها:
«المحكمة الابتدائية لمدينة كذا، القاعة رقم كذا»
أو:
«مركز الشرطة، الدائرة الفلانية، المدينة الفلانية».
ثم تثبَّتُ اللوحة المعدنية بباب إحدى غرف صاحبنا أو صاحبتنا لكي يتأتى لهما دخول القاعة كل صباح، فتغمرهما مشاعر السكنية والطمأنينة، ويتركوا غيرهم بسلام!
لكني خشيتُ أن ينقلب الموظف عليَّ…
تراجعتُ عن لوم المرأة، ثم لمتُ الموظف؛ قلتُ:
-ربما لم يستقبلني أثناء دخولي إلى الإدارة بكل ذلك الأدب إلا إشفاقا عليَّ لشيخوختي وظهور أعراض الإنهاك والمرض على ملامحي ومشيتي.
ثمَّ، أمام غياب شاهد معي من النوع الذي يتوفر عليه الشيخ الداعية المغربي المزواج، في ورطته الأخيرة مع أحدث زوجاته وأصغرهن، والتي روت فيديوهات عديدة في اليوتيوب تفاصيل فضيحة الشيخ الملتحي بالتفصيل الممل… أمام غياب شاهد معي، فقد يلفق لي الموظف تهمة ما، أقلها «إهانة موظف أثناء مزاولة عمله». وفي هذه الحالة، سيكون الحُكم القضائي دائما في صالح رافع الدعوى، وستكون العقوبة كبيرة، لاسيما عندما يكون الموظف شرطيا أو دركيا أو عسكريا! صرفتُ انتباهي عن الموضوع، خاطبتُ الاثنين في سري:
-«بيناتكم أبيضاوة! ( = أمركم بينكم يا أهل الدار البيضاء! = لا شأني فيما بينكم)…
لحظات، وها هو موظف الأرشيف / الاستقبال يناديني باسمي، استجمعتُ قوايَ، وها أنا واقفٌ أمامه. تحقق من الوثائق واحدة واحدة، قال:
-حسنا!
ثم شرع في طرح أسئلة:
-هل تسكن في العنوان المثبت في بطاقة تعريفك؟
-نعم؟
-هل لديك أبناء؟
وها نحن أمام ما بدا لي فخا نصبه لي الموظف: طرح سؤاله بصيغة مبهمة لا توضح هل المطلوب هو معرفة هل لي أبناء أم هل يسكن معي أبناء. ما المقصود بهذا السؤال؟ هل المقصود هو مجرد معرفة ما إن كنتُ أبا، بصرف النظر عما إذا كان أبنائي صغارا يسكنون معي في البيت أو كبارا استقلوا عني وغادروا المنزل ليقيموا في بيوت أخرى، وفي هذه (الحالة الأولى) سيكون جوابي هو «نعم، لي أبناء» أم المراد هو معرفة ما إن كان لي أبناء يقيمون معي في البيت، وفي هذه الحالة، سيكون جوابي المنطقي هو «لا»، لأني أسكن وحيدا. هممتُ بالإشارة إلى غموض السؤال، وتوضيح وجه الإبهام بعرض التفاصيل السابقة على الموظف، خشيتُ أن يتهمني الموظف بالتفلسف. قدمتُ جوابا يغطي الاحتمالين ليستخلص منه الموظف ما يريد:
-نعم لي ابنان، كبرا وغادرا البيت!
قهقهه ساخرا:
-يا سيدي نحن لا يهمنا أن يكون أبناؤك صغارا أو كبارا، ولا شأن لنا في أن يقيموا معك أو لا يقيموا! قلْ: «عندي أولاد» وكفى!
قلتُ:
-عندي أولاد وكفى!
كم عددهم؟
-اثنان.
كتب الرقم بسرعة، ثم عاد يسأل:
-هل أنت متزوج أم مطلق؟
لاحظتُ غياب إرداف هذين الاحتمالين باحتمالات أخرى، مثل: «معاشرة حرة»، «مخطوب»، «مصاحب»، «علاقة ملتبسة» (على حد تعبير الفايس بوك)، «على وشك الطلاق»، وما إلى ذلك، من سائر أنواع العلاقات التي تمتلئ بها دهاليز مجتمعنا، هممتُ بتنبيهه إلى ذلك، خشيتُ أن ألقى مصير الشاعرة الأمازيغية المعتوهة التي اعتصمت في أحد مطارات المملكة بحجة عدم وجود الخط الأمازيغي في البطاقة التي كان يتعين عليها تعبئتها، مع أنَّ ما يفرق بيني وبين صاحبتنا يعادل ما بين السماء عن الأرض. قلتُ:
-مطلق!
-يجب إحضار نسخة من عقد الطلاق!
وها هو حماري يقف في العقبة! كدتُ أصرخُ في وجهه:
– ولكن هذه الوثيقة، أسيدي، غير مثبتة في قائمة الوثائق المطلوبة. ها هي القائمة معلقة في الجدار. لماذا لم تكتبوا الوثيقة في القائمة؟ ثم لماذا لم تطلبوها مني يوم أمس فأعرف ما ينتظرني؟!…
لكني خشيت أن يرد عليَّ بما لا تُحمد عقباه… وقف حماري لأن الطلاق يعود إلى حوالي عشرين عاما فقدتُ فيها وثائق كبيرة أهم من هذه الورقة بكثير، فكان من الطبيعي أن يكون صك الانفصال في مقدمتها، وأن يكون آخر ما يمكن أن أحيطه بالعناية اللازمة والحرص الكبير، لاسيما أني طلقتُ المؤسسات قاطبة… مرَّ شريط علاقات ما بعد الطلاق في ذاكرتي بسرعة البرق: أسماء بعضها موجودة هنا، وليس الكشف عنه مما يحق ولا مما يليق…). كذبَ من قال لا تمر وقائع الذاكرة أحيانا في اليقظة بالسرعة التي تجري بها وقائع الحلم… لو استرسلتُ في ذكر أربع قصص منها لا غير لما أنهيتُ النص الليلة، وربما اقتضت كل علاقة رواية منفردة، وليس ذلك في نيتي… لو امتثلتُ لطلب الموظف، لاقتضى مني الأمر شد الرحال إلى مدينة بعيدة، ولوجدتُ نفسي ثانية أمام الإدارة، وما أدراك ما الإدارة، ها نحن ما زلنا فيه! أجبته بصوت خفيض:
-فقدتُ الوثيقة، ومن الصعب جدا أن أعثر عليها!…
ربما اقتنع بأني كنتُ صادقا، ربما تذكر أنه شطَّ في عمله فطلب وثيقة غير مطلوبة أصلا في قائمة الوثائق المعلقة في نسختين بجدران الإدارة، ربما فطن من صوتي إلى أني كنتُ منهكا، فمن الناس من يعرف حالة غيره الصحية من مجرد سماع كلماته، نموذجهم أحد أعز أصدقائي وزملائي في العمل: لا يكلف نفسه عناء السؤال؛ ما إن أتبادل معه بضع كلمات عبر الهاتف حتى يقول:
-أنا مسرور جدا، أنت الآن بخير، في حالة صحية جيدة. عرفتُ ذلك من صوتك…
أو:
-ماذا ألم بك؟ عرفتُ من صوتك أنك لست على ما يُرام. تناول الدواء الفلاني. خُذ قسطا من الراحة!
وما إلى ذلك..
قبلَ الموظفُ أن يحتفظ بالوثائق، لم يرددني خائبا. فرحتُ، قال:
-حسنا: سننظر ما يقول النظام système ( = قاعدة البيانات المعلوماتية). إذا تبين أنك طالق فلا حاجة لنا بالوثيقة، إن يتضح العكس فستُلزمُ بإحضارها، موعدنا غدا.
غام ذهني، اعترضتُ على الموظف سائلا إياه في نفسي:
-ما دام «السيستام» يعرف عنا كل شيء بالفعل، لأنه يحصي أنفاسنا، ويدون كل شيء عنا، فلماذا تطالبونا في كل مرة بإحضار ملف كامل من الوثائق، وبإحضار الملف نفسه، مجددا؟ أليس من الأولى أن تطالبوننا فقط بمستجدات حياتنا التي لا يعرفها النظام؟!
قلت له:
-من الصعب علي أن أحصل على هذه الوثيقة! سأقترح حلا.
-ما هو؟!
-أحضر وثيقة إدارية من مؤسسة عملي تثبتُ إحدى خانات بياناتها حالتي العائلية.
-عد غدا، وننظر ما يكون.
اليوم الثالث:
يومه، صادفتُ الموظف السابق في باب البناية، ربما كان خارجا ليتناول وجبة الغذاء في مطعم. وجدتُ نفسي وحيدا في قاعة الانتظار، لم يأبه لوجودي البوّاب الذي عوَّضَ حارس الأمس الذي صرخ في وجه المرأة ولاججها، استغرقتُ في قراءة الكتاب الذي كان معي، مرت لحظات، وها هو الحارس يجلس في كرسي الموظف الذي صادفته في باب البناية، اتجهتُ نحوه، سألني:
-ماذا تريد؟
-الوثيقة الفلانية.
-هل أودعت ملف طلبها؟
-نعم، يوم أمس.
-ما الاسم الكريم؟
-فلان.
استغرق في تقليب الوثائق، وها هو يمدني بها، استلمتُها، تنفستُ الصعداء، تهيأت لمغادرة البناية بسرعة البرق، استوقفني:
-مهلا! مهلا! تحقق من عدم وجود أي خطأ في الكتابة!
مسحتُ الورقة بعيني، قلتُ:
– لا يوجد أي خطأ!
ثم مرقتُ من البناية خشية أن يعود موظف يوم أمس، فيطالبني بإحضار الوثيقة المعلومة، وإن كنتُ مستبعدا في قرارة نفسي أن يعود، لأنه ربما تحاشى بغيابه ذاك أن يجد نفسه في موقف محرج، وهو أنَّ الإدارة أنجزت وثيقتي دون حاجة إلى الوثيقة الإضافية التي طلبها مني من دون وجه حق…
مرقتُ آملا ألا أعود إلى هذه الإدارة أبدا عملا بمقولة المذهب الذي اعتنقته منذ نعومة أظافري: «عندما يتعلق الأمر بقضاء غرض إداري مَّا، فإنَّ حماري يقف دائما في العقبة، لذلك لا تطأ قدمي بابها إلا للضرورة القصوى».