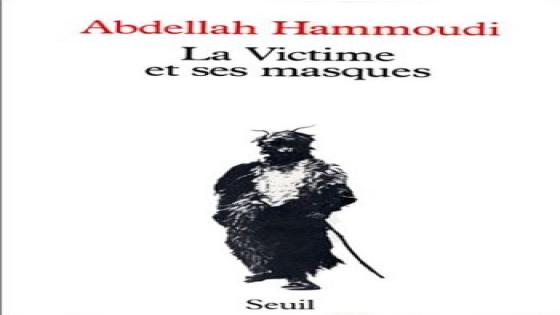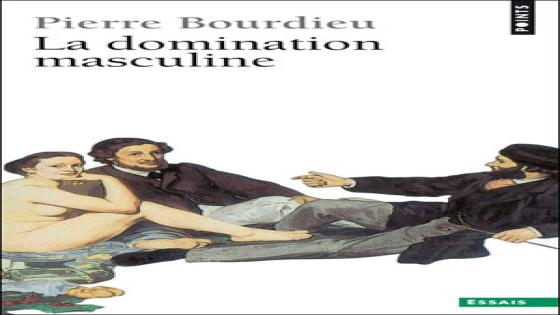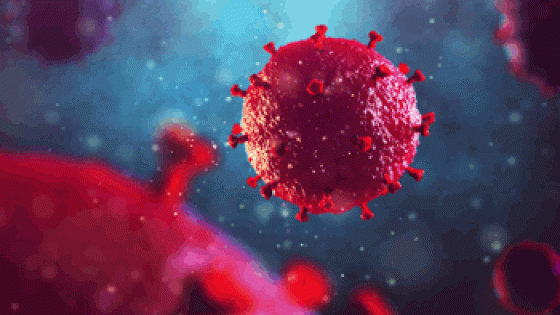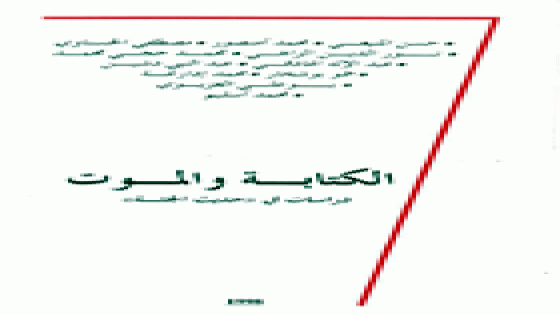سبق لنا القول إن ظاهرة وجود الملكين ببابل، «هاروت وماروت»، في الوجود الباطني لعاصمة العراق القديم، إنما هو من باب الابتلاء والامتحان الموجهين صوب العبد المسلم العالم البالغ إلى مراتب عليا من العلم عن قوى الطبيعة وعوالمها وظواهرها الخفية، وهي المراتب التي أهلته للبلوغ إلى حيث يوجد الملكان المذكوران، ولو كان هذا المرء جاهلا، أو عاميا بسيطا لما بلغ، ولو بلغ صدفة لما قيل له «إنما نحن فتنة فلا تكفر»، أي «إن ما سنعطيك إياه فيه قدرات باهرة قد تثنيك عن إيمانك وتحولك عن المحجة البيضاء التي سرت عليها سابقا والتي لا يزيغ عنها إلا الهالكون»، بل لو كان ذلك العبد عاميا لتكفلت به الشياطين، ولعلمته مثل ما نراه عند السحرة الكثر، الذين تعج بهم أقطار الأرض، والذين هم أقرب إلى الشعوذة منهم إلى السحر الحقيقي الفتان والأسر والقاهر، والذي وصفه الحق عز وجل في آية من آياته البينات بالعظمة، بمعنى القوة على التأثير الفعال وعلى التغيير والتلبيس.
إن سحر الملكين ببابل (هاروت وماروت) ليس إذن من قبيل سحر هؤلاء. فهو لا يقوم على قلب كلام الله وتحريفه عن مواضعه، ولا على لمس كتابه العزيز الحكيم بالنجاسة، أو وضعه في غير مواضعه من الطهارة والنقاء، كما أنه سحر لا يقوم على سب الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم (حاشى الله عز وجل ورسوله الكريم) أو على التمسك بأهداب أئمة الكفر من شياطين الجن والإنس، بل هو «علم رباني عن «عالم القوى» الذي يمارس تأثيره بإذن الله عز وجل على «عالم القوى» الذي يمارس تأثيره بإذن الله عز وجل على «عالم الفعل» فتتأثر به المادة والأشخاص والعقول والأفئدة وكل الأسباب الظاهرية المعروفة، فينتج عن ذلك نمط جديد من الأسباب الظاهرية المعروفة، فينتج عن ذلك نمط جديد من الأسباب غير الظاهرية فيرى الإنسان ظواهر وأشياء من دون سبب أو مسبب منظور أو معروف. وهو أيضا علم عن قوى الظلمات، وعن قوى النور وأساليب استعمالها للتأثير في قوى الظلمات ودحرها. وهنا تكمن الفتنة، عندما يصير العبد الممسك بخيوط هذا العلم المنزل من عند العليم الخبير على الملكين – كما يقول الحق عز وجل في كتابه العزيز – هدفا لشياطين الجن والإنس، ومصبا للإملاءات والإغراءات الإبليسية الملتبسة، فيتحول ما اكتسبه من العلم إلى مسؤولية ثقيلة وأمانة عظمى قل أن يصمد تحت ثقلها إنسان، خصوصا عندما يجد هذا العبد نفسه محاطا بكائنات تصدر عنها كل أشكال السحر والخوارق الممكنة، فتميل نفسه على مجاراتها والتسابق معها وتحقيق السبق عليها فيسقط في المحظور الذي ذكره الملكان وبمغبته.
قلنا إذن، إن العلم الذي يلقنه الملكان ببابل ليس سحرا شيطانيا، بل غالبا للسحر الشيطاني ومتفوقا عليه لكونه منزلا من عند الحق عز وجل، ولكنه يبدو في نظر الناس العاديين سحرا ولا يرون فرقا بينه وبين ما تمليه الشياطين وتعلمه لطالبيه، لأن الجمهور لا يدرك الفرق في المصدرين وفي القوى المستعملة وفي نقط الاستمداد، وهذا ما وقع فيه قوم سليمان عليه السلام فاعتقدوه ساحرا، وهو عين ما وقع فيه مؤلف هذا الكتيب، إذ نجده لا يقيم أي فاصل أو تمييز بين النوعين المذكورين من السحر أو بالأحرى بين «تطويع قوى الطبيعة والقوى العقلية بوسيلة دينية نورانية، وتطويعها واستعمالها بوسائل ظلماتية شيطانية»، وهذا بالذات ما جعل المؤلف يسوق إلينا طرحين متناقضين حول انتماء العبدين اللذين أنزل الله سبحانه عليهما ذلك العلم ببابل، يقضي الأول بكونهما ملكين من الملائكة، والثاني بكونهما ملكين من الملوك، وهذا الاقتضاء الثاني يؤهلهما لأن يكونا بشرين أو من الجان، وبالتالي كافرين، وهذا لا يجوز مطلقا لأن العبدين المعنيين يقول كتاب الله إن الحق عز وجل أنزل عليهما ما يعلمانه للناس ويقولان لهم إنما نحن فتنة، وينصحانهم بالاحتراس من الوقوع في الفتنة وفي الكفر، وقد كان ينبغي للمؤلف أن يقطع في هذا الشأن وبين الطرح الأصوب وهو الأول، ويفند الطرح الأبعد عن الصواب وهو الثاني، فيقي القارئ بذلك من اللبس والخلط والارتباك.
(إن السحر في حقيقته – وهذا يعلمه كل السحرة حتى ضعافهم – ينبني على تحريك قوى العقل لتطويع المادة وللتأثير في الظواهر الطبيعية والطباع الإنسانية بعد جعل قوى العقل في حالة استمداد من قوى كونية وطبيعية خفية منها قوى الكواكب، بواسطة التماس مواقيت معينة؛ أو قوى النبات، عن طريق البخور النباتي؛ أو قوى الحيوانات، عن طريق تقديم أجناس معينة منها قربانا للمخاطب (بالنصب) في الطقس السحري…، الخ.
فالعقل إذن، بواسطة قواه، هو الذي يجعل الفعل السحري ممكنا. ولذلك نسمع المثل الشائع القائل «إن السر ليس في النون بل في سحنون» والذي يفيد بأن استعمال حرف «النون» لأداء فعل سحري لا يتيسر اعتمادا على هذا الحرف وحده، ولكن على قوى عقل الشخص المستعمل له (بالكسر). ولو كان الأمر بخلاف ذلك لكان في وسع كل من هب ودب أن يمارس السحر وطرائقه المختلفة، ولكان كل الناس ساحرا متمكنا، ولكان السحر يلقن ويعلم في الأقسام الابتدائية ومنذ الطفولة الأولى!
ومادام العقل وقواه هما أساس العمل السحري، فإن القول بلا عقلانية السحر يصبح كلاما بلا أي معنى. وقد وقع المؤلف في هذا المطب (كغيره) حين قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أصيب بسحر «لبيد بن الأعصم» جرب «النظام العقلاني»، فلجأ إلى الحجامة لاعتقاده بأنه مصاب بمرض جسدي عضوي، ثم انتقل إلى «النظام اللاعقلاني» والذي هو نظام السحر، فتلا المعوذة التي نزلت عليه لهذه الغاية وأعاد قراءتها على المادة السحرية (الحبل المعقود) بعد استخراجها من الجب فكانت عقدها تنحل الواحدة تلو الأخرى في كل مرة حتى انفكت عن آخرها.
إن هذا الكلام واقع ولكنه غير صائب، لأن ما نراه تحت تأثير الحضارة المادية الوجودية السائدة وبمنظور العلمانية والعقلانية المهيمنتين أمرا غير عقلاني، إذا به في حكم الدين، وبالدليل القرآني الراجح والقاطع من فعل العقل وقواه كما سبقت الإشارة. إن المؤلف في مقولته بلاعقلانية السبب الثاني الذي لجأ إليه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يكاد ينعت فعل إزالة المفعول السحري باللاعقلانية بتحصيل الحاصل، وهو يعلم أن ذلك الفعل لم يكن سوى الاستخدام النوراني والحق لآيات كريمة نزلت لذات الغرض. فهل ذلك حقا أمر بعيد عن العقل؟ بالطبع لا، وهذا خطأ فادح من أخطاء الطرح الذي نحن بصدد التعليق عليه. إن العقل هو الذي يؤدي الفعل السحري بواسطة قواه، ومن ثم فإن هذا الفعل عقلاني بكل المقاييس»!!
(يقول المؤلف في الفقرة الأولى من الفصل الثاني، تحت عنوان «الحديث النبوي»: إن الحديث يعتبر تطبيقا للتعاليم القرآنية. فهو لا ينفصل عن القرآن، بل يعد المصدر الثاني للإسلام بعد النص المنزل لهذا السبب «تم تدوينه مثل القرآن» في وقت مبكر للحفاظ عليه…
والحال إن المؤلف وقع هنا في خلط فظيع!
فالقرآن الكريم لم يدون كما دون الحديث بتاتا، لأن كلام الله عز وجل محفوظ بحروف وبحساب دقيق وضعه الحق عز وجل بعلمه الرقمي المطلق، وجعل له نجوما لها مواقع معينة في أماكن محددة من الآيات، وجعله آيات وسورا وأحزابا، فكان تدوينه مسبق الحبكة من عند العليم الخبير، فلم يفعل المدونون سوى أنهم وثقوه كما هو دون أدنى زيادة أو نقصان، اللهم إلا ما ورد من الخلاف في بعض مناطق الكلمات مما لا تأثير له على النص وفحواه. ومن هذا الخلاف جاءت القراءات المتعددة. وقد أجمع الأئمة والجمهور على إجازتها جميعا. أما الحديث فقد تم تدوينه بناء على قناعات وملكات حفظ شخصية ذاتية فيها الكثير من النقص والسهو ومن الإضافة والخلط، وفيها من الزيادة والنحل الشيء الكثير، ولذلك احتاج تدوينه إلى إسنادات وإلى معايير كثيرة تهدف إلى التدقيق والتصحيح والتطهير من الشوائب.
ثم إن الحديث النبوي لم يكن مطلوبا تدوينه أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي خاف عليه الصلاة والسلام أن يأخذ الناس كلامه من بعده مأخذ الكلم المنزل والمنزه عن الزيادة والنقصان، لعلمه بأن هتين الخاصيتين لا تتوفران إلا في الذكر الحكيم.
لقد قال الحق عز وجل إنه منزل الذكر وحافظه، ولذلك جاء الذكر الحكيم حاملا جميع متطلبات التوثيق والحفظ والتدوين، ولم يأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتدوين حديثه للسبب المنوه عنه، فدون من بعده فجاء لذلك حاملا لما نعرفه جميعا من الزيادات والنقائص والبدع مما استدعى بذل جهود التصحيح والتنقية والتهذيب، وتطلب صدور الصحيحين، والموطآت ونحو ذلك.
هكذا جعل المؤلف عن غير قصد بكل تأكيد، مساواة في فعل التدوين وفي الحفظ بين كلام الله عز وجل وكلام رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم، في حين أن الأول محفوظ من لدن الحفيظ جل وعلا، وأن الثاني، وإن كان غير صادر عن الهوى في أساسه الأول، فإنه تعرض لتدخل الإنسان وعبثه وظلمه وجهله قبل تدوينه وأثناءه وبعده على السواء.
(يقول المؤلف ضمن نفس الفصل إن إصابة الرسول صلى الله عليه وسلم بالسحر اقتضت «تدخل البشر والملائكة والله في آن واحد». وهذا فيه خلط أيضا، إذ أن تدخل الملائكة بتحديد أسباب المرض والإصابة وتحديد الفاعل ومكان المادة السحرية، وتدخل البشر بإحضار مادة السحر من قعر البئر، إنما جاءا معا في سياق الإرادة الإلهية، ولذلك لا يسعنا القول – كما قال صاحبنا – إن هناك تدخلا في آن واحد للبشر والملائكة وللحق عز وجل.
إن الله سبحانه إذا أراد قضاء فإنما يقول له كن فيكون، وقد جعل في سياق إرادته وحكمته المطلقتين أن يصاب رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم بالسحر، وأن يشفى منه على يد كرام بررة، وأن يقوم بعض الصحابة ببعض الترتيبات المادية اليسيرة دون أن يكون لأحد غير الله سبحانه أدنى تدخل بالقوة والفعل معا في هذا الموقف، لأن كل ذلك إنما كان بتدبير منه سبحانه وتعالى مسبق.
وسنلاحظ في هذا السياق بالذات كيف أن المؤلف وقع مرات متكررة في نفس الخطأ، حين ساوى بين الحقيقة القرآنية واجتهاد الفقهاء، وحين وازن بين تدوين كتاب الله وتدوين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم في هذا الموقع الأخير حيث يساوي في فعل التدخل بين الحق عز وجل والبشر والملائكة. وليت المؤلف الكريم يفطن إلى هذا الأمر حتى لا يختلط الناسوت باللاهوت، أو العكس، فيما هو خائض فيه من هذا الضرب من الموضوعات بالغة الدقة، وبالغة الإحراج، والمحفوفة بالمزالق والمطبات!
(يقول المؤلف، إن الوحي يقول: «إن الناس يتعلمون من ملكي بابل هاروت وماروت وسائل زرع التفرقة بين الرجل وزوجته…» وهذا كلام مكذوب، فكتاب الله لم يقل ذلك بتاتا، بل قال ما معناه إن الناس يتعلمون من الشياطين السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، وإن هذين الملكين يقولان للمتعلم إنما نحن فتنة فلا تكفر، والشياطين لم يقولوا ذلك، كما أن الملكين لديهما أمر أنزله الله عليهما لحكمة يعلمها هو سبحانه.
إننا هنا بإزاء موضوعين مختلفين:
– موضوع السحر الذي يعلمه الشياطين للناس!
– وموضوع «ما أنزل على الملكين ببابل» من عند الحق عز وجل. وهذا كما سبقت الإشارة لا يجوز أن يكون سحرا كذلك الذي تلقنه الشياطين، ومن ثم فإنه لابد أن يكون علما يشبه السحر في الفعل والأثر، ولكنه علم نوراني لأنه من عند العليم الخبير، ولا نحتاج إلى القول: إن العليم الخبير لا ينزل السحر على أحد، لأن السحر – كما يؤكد المؤلف نفسه – نقيض للدين، أي نقيض لكل ما هو نوراني من عند الله سبحانه. لكأننا بالمؤلف هنا يضع فكرة مسبقة في ذهنه ويحاول أن يجد دليلا عليها من الكتاب وبأي وسيلة، بينما كان من الأجدى أن يفحص ما جاء في كتاب الله العزيز، ثم يحاول من خلاله أن ينظر إلى جوانب الموضوع المطروق، وهو الأسلم. بل إن فعله ذلك جعله يقول الوحي ما لم يقله ويخلط في ذلك بين ما يعلمه الملكان ببابل تنزيلا من عند الحق عز وجل، وما يعلمه الشياطين الكفرة وينسبونه إلى سليمان عليه السلام وهو منه براء. بل إن المؤلف يخلط بين هذا القول وبين الحالة التي وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه فيها بعد أن أصابه سحر اليهودي لبيد، من وهن ونسيان وسقوط للشعر، فكان هذا السحر بالضرورة من ذاك الذي يعلمه الملكان، والحقيقة أن الملكين يعلمان علوما عن القوى وعن أسرار التحكم في المادة وفي الكائنات وفي الظواهر وفي السحر ذاته، ويجعلان المتعلم على بينة مما يشكله ذلك من الفتنة فينصحانه بالتالي بالحذر من السقوط في متاهة الكفر إذا هو استعمل ذلك العلم فيما هو غير أهل له.
ويمكننا أن نعبر عن هذه الفكرة التصحيحية بالقول: «إن الملكين يعطيان مادة خاما، ثم إن الممسك بهذه المادة هو الذي يحولها إلى عمل نوراني أو ظلماتي وإلى سلاح ضد السحر أو سحر بعينه، فيكون هذا التحريف من فعل الإنسان أو العبد المتعلم، وليس من فعل الملكين» فوجب الانتباه إلى هذا اللبس.
دعونا في هذا المستوى نتساءل عن ماهية السحر وعلاقته بالساحر؟
إن الساحر يستعمل أدوات ووسائل في متناول كل الناس، فالناس جميعهم في مستطاعهم الحصول على البخور الذي يستعمله الساحر، وعلى المداد الخاص، وفي وسعهم تعلم التعزيمة، وضبط التوقيت بالقياس إلى الأبراج والمواقع والمنازل الكوكبية، وفي مستطاعهم إجراء العمليات الحسابية والجبرية التي يمارسها السحرة على اسم الشخص المستهدف واسم أمه أو نحو ذلك، ولكن، إن ذلك كله لن يجعل من هؤلاء الناس كلهم سحرة أو حتى أشباه سحرة، لأن السر في نجاح فعل الساحر يكمن كما سبق القول في قوى عقل هذا الأخير، وفي السنوات الطوال التي قضاها في التركيز العقلي وفي طقوس تصاحب هذا التركيز، حتى تصبح قوى العقل أداة للتجميع والضبط والتوجيه، وهكذا تتحول الأدوات والوسائل الأخرى المذكورة من بخور وغيره إلى ضربات فاعلة ومؤثرة لأنها ملبوسة بقوى عقل الساحر وحضوره الضروري وبالمغناطيسية الذاتية المنبعثة من شخصه وكيانه… وهذا بالذات ما عبرنا عنه أعلاه بذلك المثل الشائع «القضية ليست في النون بل في سحنون». وهذا بالذات، أيضا، ما يؤكد قولنا إن الفاعل في العمل السحري ليس هو العلم نفسه ولا ملقنه، ولا حامله من كتاب أو غيره، بل هو الساحر نفسه بعقله وقوى عقله وبقدرته على التركيز العقلي الفاعل والفعال، وبمغناطيسيته الذاتية التي استطاع على مر السنين والمجاهدات أن يجعلها قابلة للتجميع والتركيز والتوجيه إلى حيث يريد، وهنا تتدخل مادة السحر من بخور وتمائم وذبائح لتشكل الإطار الملائم لحدوث الفعل المطلوب.
ولنفهم هذا الموقف أكثر، في وسعنا أن نتخيل الفعل السحري بمثابة رصاصة تثبت داخل بندقية هي مواد السحر وأدواته، ويوجهها مصوب ماهر لا يخطئ الهدف هو الساحر، وكم من بندقية توجد بين أيدي أصحابها وهي مشحونة بالذخيرة، ولكن عدم توفر المهارة في التصويب لدى هؤلاء يجعل وجودها كعدمه، ويفقدها أي ميزة إذا قورنت (نقصد البنادق) بالهراوات أو بأي شيء آخر غير حربي!
إن الأمر، بعد الله عز وجل، في يد المتعلم الذي يمسك بأسباب الفعل السحري ويتقن استعمال هذه الأسباب، وهذا هو الذي افترق على خطين:
خط تلامذة الملكين ببابل (هاروت وماروت) وهؤلاء عالمون استطاعوا بنا لديهم من العلم أن يخترقوا فجاج الأرض فيصلوا إلى حضرة الملكين. وهؤلاء هم الذي يجوز تذكيرهم بأن ما بين أيديهم فتنة، وكذلك شأن من علمهم ولقنهم ضروب القوى (النورانية والظلماتية) وأصنافها وطرق استخدامهما وتسخيرها المختلفة، وهؤلاء التلاميذ العالمون هم الذين عليهم أن يتقوا الفتنة.
وخط تلامذة الشياطين الذين كفروا، وهؤلاء، التلامذة غير عالمين، بالمفهوم الديني للعلم، بل هم مشروع سحرة فحسب، فيتعلمون لذلك ما يفرقون به بين المرء وزجه وما شابه ذلك مما نعرفه عن السحر في مجمله.
ولو سأل سائل: فما رسالة الفريق الأول إذا لم يكن نظيرا للثاني في علمه وفنون تطويعه للقوى الخفية؟ لكان الجواب: إن هذا الفريق الأول غير قادر على دحر السحرة وإبطال أعمالهم، فكأنه جيش ضمن صفوف جند الله يخوض حربا باطنية ضروسا هدفه فيها تكبيل الشياطين ما أمكن، وإفساد مفعولهم ومفعول ما يعلمونه من السحر للناس، وسحق كل قوى باطنية ظلماتية يجدونها في طريقهم أثناء تجوالهم الباطني، وهؤلاء متى أصابتهم الفتنة ووقعوا في حبال الغواية فإنهم يتحولون إلى كفرة فجرة أشد فتنة وإيذاء من أعضاء الفريق الثاني… وهذا بالذات، موضوع التحذير الذي يردده الملكان هاروت وماروت على مسامع الوافدين إليهما من طالبي العلم.
إننا هنا أيضا نصحح ما جاء به المؤلف حين ساق حكاية المرأة التي جاءت لتشكو حالها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته قد فارق الحياة، فقصت قصتها على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، والتي مفادها أنها توجهت إلى هاروت وماروت، ببابل، بمساعدة عجوز شمطاء (ساحرة متضلعة) وطلبت منهما أن يعلماها السحر فنصحاها بالرجوع، ثم كان ما كان من عنتها وإصرارها، بعد خوف وتردد في بادئ الأمر، فتعلمت ما جعلها قادرة على تطويع الأشياء والظواهر الطبيعية، فلما رأت ما صار يتصرف على يدها خافت الله وعقدت العزم على التوبة وعلى مفاتحة الرسول صلى الله عليه وسلم عسى أن يجد لها مخرجا.
إن المؤلف يقدم القصة هكذا بدون أدنى تدخل لتبسيطها للقارئ حتى لا يدخل في روع القارئ إن الملكين يعلمان السحر كالشياطين. ذلك أن المرأة كانت مسلمة مؤمنة تقية، بدليل خوفها وترددها في بداية الأمر، ثم ندمها وتوبتها في نهايته، وهذا يؤكد مقولتنا السابقة، من أن البلوغ إلى الملكين ببابل يتطلب قدرا كبيرا من الإيمان ومن قوة البصيرة، ولاشك أن ذلك توفر للمرأة المذكورة، كما أنه يجعل البالغ أمام علم لا يفضي بالضرورة إلى الكفر، بل يسع المرء الذي يكتسبه أن يتقي الفتنة مع حمله إياه، وأن يتوخى عدم استعماله فيما يغضب الله عزل وجل، وقد كان هذا بالذات موقف تلك المرأة المؤمنة المحتسبة.
ولو أن هذه المرأة كانت عادية الإيمان أو متشككة لوجدت نفسها بإزاء الشياطين، بدلا من الملكين، ولتعلمت سحرا هو أقل شأنا مما يعلمه الملكان، ولكانت فاسقة في الأساس، لأن هذا النوع من الفن – ولا نسميه كلما كالآخر – لا يتحقق اكتسابه إلا بالممارسات المعروفة والتي يدخل فيها الرجس والردة والكفر ومخالطة أهل السوء… إلى آخرالقائمة السوداء !
هذه إذن مجرد ملاحظات عجولة أردنا بها لفت نظر مؤلف كتيب «الإسلام والسحر» قبل غيره، ثم قراء الكتيب الكرام، إلى أمور تلتبس كثيرا على الناس فنجدهم من باب استسهال الأمور يعممون الأحكام والأوصاف والنعوت فلا يفطنون إلى فوارق ومميزات قائمة بين الأشياء وكامنة فيها ترفع عنها أوجه الشبه وتجعلها متفاضلة عن بعضها كل التفاضل ومتمايزة كل التمييز، وهذا ما أشرنا إليه في تفريقنا بين الحقيقة الدينية في القرآن الكريم واجتهادات الفقهاء، وبين تدوين الآيات القرآنية وتدوين الأحاديث النبوية؛ وبين تدخل البشر والملائكة في دفع الضرر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكون الله عز وجل مشاركا في هذا الفعل من جهة، وصدور كل ذلك عن الإرادة الإلهية من جهة ثانية؛ ثم بين العلم الذي يعلمه الملكان ببابل «هاروت وماروت» والذي هو أمر منزل عليهما من أعلى عليين، وما يعمله الشياطين الكفرة للناس مما يفرقون به بين المرء وزوجه… فما أكثر الشبه بين هذه الثنائيات ظاهريا، وما أعمق الفرق بينها في باطنها وحقيقتها الدينية… وللحديث – ربما صلة.
(نشرت هذه الدراسة، في الأصل، ضمن الملحق الثقافي لجريدة الميثاق الوطني، الأحد – الإثنين 13-14 غشت 2000، العدد: 7444)
الكاتب: محمد أسليـم بتاريخ: السبت 08-09-2012 10:31 مساء